|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 77639
|
|
الإنتساب : Mar 2013
|
|
المشاركات : 741
|
|
بمعدل : 0.17 يوميا
|
|
|
|
|
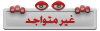

|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
 الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي فقيهاً
الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي فقيهاً
 بتاريخ : 08-04-2013 الساعة : 08:39 PM
بتاريخ : 08-04-2013 الساعة : 08:39 PM
الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي فقيهاً

بقلم : السيد محمد طاهرالياسري الحسيني
للشيخ عبد الهادي الفضلي أحد أشهر علماء الإحساء المعاصرين دور علمي بارز، وهو علاوة على ذلك متنوَّع المعرفة، فضلاً عن توفره على البُعد التوفيقي بين الموروث المعرفي الذي يبدو في دراساته وأبحاثه ومساهماته في ما يعرف بـ(حوزة النجف الأشرف)، وبين دراساته الأكاديمية والجامعية.
وإذ انتمى الشيخ الفضلي لمنطقة الإحساء، تلك المنطقة الزاخرة بالعلماء والأدباء، فإنه ينتمي – أيضاً – إلى مدرسة النجف الأشرف، وهو ابن العراق ولادة ونشأة، وقد نمته هذه المدرسة بما زخرت به من أعلام المعرفة وروّاد العلم، وتتلمذ على أشهر الفقهاء والعلماء من أمثال السيد محسن الحكيم والسيد أبي القاسم الخوئي والشهيد السيد محمد باقر الصدر.
وبخصوص الشهيد السيد محمد باقر الصدر نشير إلى شدة تأثر الشيخ الفضلي به وصلته الوطيدة به، وهي صلة تاريخية تتعدى البعد العلمي.
والشيخ الفضلي شديد الإعجاب والإكبار لأستاذه، إن على المستوى العلمي أو على المستوى الأخلاقي، بل والسياسي... ولا يترك مناسبة إلاّ ويشير فيها إليه، فهو وإن كان في سياق البحث الفقهي، فإنه لا يغفل الإشارة إلى الزهد – مثلاً - الذي تحلّى به الشهيد الصدر، وهو بصدد البحث عن الشروط التي يتوفر عليها (مرجع التقليد)(1).
وفي السياق نفسه يشير إلى الدور الريادي للشهيد الصدر في تصعيد العمل المرجعي، ابتداءً من الإشارة إلى ما اشترطه الشهيد الصدر في المرجع زيادة على ما اشترطه الفقهاء، وهو شرط الكفاءة الإدارية(2)، ومروراً بالتنظير لهذا العمل المرجعي ووضع التصورات اللازمة للنهوض به(3)، وانتهاء بالإشارة إلى آرائه ونظرياته في عدد كبير من أبحاثه الفقهية وغير الفقهية، بل قد يشير الشيخ الفضلي إلى بعض آراء الشهيد الصدر التي لم ترد في أبحاث الشهيد الصدر وكتاباته، بل أنه ينقلها عنه شفاهاً – كما أشار فعلاً – إلى رأي الشهيد الصدر في جواز حلق اللحية(4)، وإن كان أفتى الشهيد الصدر – من باب الاحتياط – بعدم الجواز.
وبشكل عام يمكن القول: إن بصمات مدرسة النجف واضحة إلى حد كبير في فقه الشيخ الفضلي ومنهجه.
وقد لا يكون التتبُّع الشامل لخصوصيات المنهج الفقهي للشيخ الفضلي ممكناً في مثل هذه (الوجيزة)، فإننا يمكن أن نشير إلى الملامح العامة لهذا المنهج:
أولاً: الفهم العرفي
إن قراءة النصوص الشرعية لا تختلف عن قراءة أية نصوص أخرى صادرة باللسان العربي، ولذلك لا يختلف التعاطي مع نص شرعي عن التعاطي مع أية وثيقة مكتوبة باللغة العربية أو تنتمي إليها، وذلك لجهة أن الشارع في أسلوبه البياني اللغوي لا يبتعد عن الأسلوب العرفي الذي يتبانى عليه الناس وفقاً لأصول وقواعد المحاورات عندهم، إذ يقول السيد الخميني: >وليس مخاطبة الشارع مع الناس إلاّ كمخاطبة بعضهم لبعض<(5).
ولهذه الجهة دأب الفقهاء على فهم هذه النصوص وفقاً لما عليه العرف، إلى درجة يمكن معها أن تكون مرتكزات العرف قرائن للتعميم تارة وللتخصيص تارة أخرى، كما هو الحال في ما يعرف بقاعدة (مناسبات الحكم والموضوع)، ولكن مع ذلك نجد اتجاهاً لا يستهان به في الوسط العلمي الديني يميل إلى قراءة النصوص الشرعية وفقاً للفهم الفلسفي وبآليات فلسفية، وهو ما يفسَّر تسُّربَ القواعد الفلسفية ولغة الفلسفة وأدواتها إلى المتون الفقهية والأصولية. وهو ما يفسر – أيضاً – الاختلاف الجوهري بين المتأخرين والمتقدمين في طرق الاستدلال بل وفي اللغة والتعبير، بحيث يلاحظ الباحث أن لغة المتأخرين باتت مثقلة باصطلاحات الفلسفة والمنطق بما لم يعهده البحث الفقهي في متون المتقدمين.
وفي هذه المسألة بالذات حدَّد الشيخ الفضلي موقفه بوضوح، إذ كتب في مقدمة كتابه (دروس في فقه الإمامية) يقول: "ولأن هناك منهجين تناول الفقهاء والباحثون قضايا الفقه ومسائله في ضوئهما، وعلى هدي تعليماتهما، وهما المنهج الفلسفي والمنهج العلمي، سلكتُ في دراستي هذه المنهج العلمي مبتعداً قدر الطاقة عن المنهج الفلسفي، وذلك لما استشعره من فرق واضحٍ بين موضوع البحث الفلسفي وموضوع البحث العلمي، حيث يتحرك الأول في عالم الفكر التكويني، ويتحرك الثاني في عالم الفكر التشريعي، والفرق بين التكوين والتشريع هو الفرق بين التجسيد والتجريد، فما يصدق من قوانين في عالم التكوين، لا ينطبق – غالباً – على عالم التشريع للفرق المذكور. ومن هنا إذا حاولنا أن نُعيَّن موقع المعاملات المالية – وهي من التشريع – سوف نصنفها في عالم الاعتبارات، لأنها غير ذات طبيعة مادية متجسدة في خارج الذهن، وإنما هي ظواهر اجتماعية تدخل ضمن فعاليات وآليات سلوك الإنسان ووفق نظام خاص بها اعتمد في وضعه اعتبار المعتبر.
وكذلك لما أُدركه بَيَّناً من الفرق بين الطريقة الاستنتاجية في البحث والطريقة الاستقرائية، حيث يعتمد الاستنتاج على التفكير المجرد ويقوم الاستقراء على ملاحظة الواقع.
وما هذا إلاّ لأن المعاملات المالية – كما قلت – ظواهر اجتماعية تعيش في واقع حياة الناس، والطريق لمعرفة الواقع هو الاستقراء. ويتجلى هذا أكثر عندما نعرف أن المصدر الأساسي للفكر الفقهي في مباحث المعاملات المالية هو سيرة العقلاء المعتبرة من قبل المشرَّع الإسلامي. والسيرة – كما هو معلوم – أنماط سلوكية تتحرك وتتفاعل في الواقع الاجتماعي. والطريق لمعرفة الواقع – لأنه من الحسَّيات – ليس الاستنتاج وإنما هو الاستقراء عن طريق الملاحظ"(6).
واعتماداً على هذا المنهج الذي حدَّده الشيخ الفضلي لنفسه فإنه نأى بنفسه في غمار البحث الفقهي عن معطيات الفلسفة وأدواتها، إذ كتب في مسألة (التخيير في التقليد) وهي المسألة التي يبحث فيها الفقهاء حكم تخيير المكلف بين تقليد الأعلم وبين غير الأعلم، إذ يقول: "... وعند قيام السيرة، لا أرانا بحاجة إلى أن نعتمد معطيات الفلسفة كما جاء في بعض كتب الفقه الاستدلالية، لأن التشريع اعتبار أمره بيد معتبره"(7) .
وقد انعكس هذا المنهج في مسألة فقهية أخرى، وهي مسألة العدول في التقليد من مجتهد إلى آخر، حيث رجّح الشيخ الفضلي الجواز بناءً على سيرة المتشرعة في مجال التقليد حيث تعرب – تاريخياً – عن أن المكلف الذي كان يسكن خراسان – مثلاً – ويرجع إلى أحد الرواة الفقهاء هناك ثم يهاجر إلى الكوفة، فإنه يرجع فيها إلى من هو موجود من الرواة الفقهاء.
ويؤكد الشيخ الفضلي هذا الرأي فيقول: "ويرجع هذا – متى بعدنا عن التأثير بمعطيات الفلسفة – إلى أن مشروعية الرجوع إلى المجتهد قائمة باجتهاده وحجية فتواه مستندة إلى دليلها، وهما متوفران في كل مجتهد توفر على شرائط الإفتاء وجواز تقليده، وقد كان هذا يقع بمرأى ومسمع من المعصومين(8) .
كما انعكس هذا المنهج في أبحاث الشيخ الفضلي في مسألة تطهير الدهن، حيث أن الفقهاء مجمعون على أن الدهن يطهر إذا أمكن استيلاء الماء الطاهر على النجس، واختلفوا في أن الدهن المتنجس إذا وضع في الماء الغالي هل يصل الماء إلى كل جزءٍ جزء من الدهن المتنجس مع بقاء الدهن دهناً، أي من غير أن يستهلك فيفنى أو يتحول إلى مادة أخرى، وذلك لأنهم اختلفوا في كيفية التأكد من وصول الماء المطهر إلى كل أجزاء الدهن المتنجس، هل هي قضية عرفية فيؤخذ فيها نظر العرف، ويكون ما يحققه العرف هو الموضوع الذي ينطبق عليه الحكم، أو أنها قضية علمية تخضع للنظر الفلسفي في تركّب المادة وقابلية عناصرها المركبة منها للتأثير بالماء فتطهر، أو عدم قابليتها فلا تطهر.
وقد أُخضعت المسألة في شق منها إلى المبدأ الفلسفي الذي يشير إلى (الجزء الذي لا يتجزأ) و (الجزء الذي يتجزأ)، وقد علَّق الشيخ الفضلي على التأثر الفقهي بالمعطى الفلسفي فيقول: "وإذا حاولنا أن نوازن بين وجهات النظر الفقهية المذكورة في أعلاه ليس أمامنا إلاّ الرجوع إلى طبيعة الفقه الإسلامي – بصفته تشريعاً – في تعامله مع الموضوعات، وبخاصة تلكم الموضوعات التي جاء التشريع الإسلامي وهي قائمة في المجتمعات البشرية يتعاملون معها ويرتبون الآثار و الأحكام عليها على أساس من معرفتهم لها. وطبيعة التشريع الإسلامي في مثلها – كما هو معروف – تقوم على إيكال تحديد الموضوع لهم. هذا هو المستفاد من تتبع الكثير من الموارد التي تعطي الاطمئنان لذلك، ومن هنا نقول: إن الأخذ بنظر العرف في المسألة هو الأمر الذي يلتقي وطبيعة الفقه الإسلامي بصفته تشريعاً اجتماعياً، مع الأخذ باعتبار أن المبدأ الفلسفي (الجزء الذي لا يتجزأ) الذي بنى عليه جملة من الفقهاء آرائهم قد أثبتت التجربة العلمية التي لا تقبل الشك بطلانه، عندما انتهى العلم التجريبي الحديث إلى إثبات انشطار الذرة"(9) .
وفي مسألة تجزويء الاجتهاد نأى الشيخ الفضلي عن الفهم الفلسفي، وطرح المسألة في ضوء طبيعة التفكير وقدرة الذهن البشري، بعيداً عن التفسير الفلسفي لما يعرف بـ(الاجتهاد) وكونه ملكة، وهي صفة راسخة في النفس واستعداد عقلي يتناول أعمال معينة بحذق ومهارة، فإن مثل هذا التفسير يرجع إلى ما أسماه الشيخ الفضلي بالتعليل الفلسفي لهذه الملكة وكونها بسيطة توجد أو لا توجد، وإن وجدت فهي لا تختلف من حيث الاقتدار على الاستنباط في هذه الجزئية أو تلك.(10)
ونظراً لترجيح المنهج العرفي عند الشيخ الفضلي على المنهج الفلسفي فقد اختار أن الاجتهاد قدرة علمية وفعل علمي، لذلك لا يصح أن يقال إنه متجزيء أو غير متجزيء، لأن القدرة العلمية هذه تعتمد على: فهم منهج الاستنباط، وكيفية تطبيق المنهج على مواده وجزئياته، وامتلاك ما يساعد على الفهم والتطبيق من وسائل علمية وآليات فنية. وهذا الفهم صفة عامة، ولأنها عامة تعني أن الاقتصار على الاجتهاد في باب دون آخر لا لقصور في القدرة العلمية، وإنما لعوامل أخرى خارجة عنها لا علاقة لها بها. ومن هنا ينبغي أن يكون عنوان الشرط – هنا – هو (الاجتهاد) فقط، أي من دون وصفه بالإطلاق أو تقييده بالتجزؤ"(11) .
وتعليقاً على ما يسمى بـ(أصالة العدم) والذي استدل به بعض الفقهاء لنفي ولاية المرأة للوظائف العامة والقضاء كتب الشيخ الفضلي: "إن مثل هذا التأصيل هو مما أملاه المنهج الفلسفي الذي اتبعه أكثر الفقهاء المسلمين في أكثر من مرحلة من مراحل تاريخ الدرس الفقهي. وهذا الأصل وضع ليرجع إليه في مقام الشك في الأمور الحادثة والولاية وصف حادث، والأمور الحادثة – كما تقول الفلسفة – إذا شك في وجودها تنفى بأصالة العدم، أي أننا أخذاً بهذا الأصل عندما نشك في ثبوت الولاية لأحد نحكم بعدم ثبوتها. قد كان هذا الأصل أقوى مساعد للفقهاء في نفي ولاية المرأة عن كثير من الأمور، ومن ثم منعها من ممارسة كثير من الأعمال والوظائف. وأول ما يلاحظ على هذا الأصل، هو أن هذا الأصل معدود من مبادئ المنهج الفلسفي العقلي الذي يقوم على أساس من الاستنتاج العقلي. والفقه لأنه تشريع تستقى مادته من المصادر النقلية (الكتاب والسنة) تكون الطريقة السليمة لدراسة قضاياه، هي الاستقراء لا الاستنتاج، نتتبع فيه بغية الوصول إلى الحكم الخطوات التالية:
1- مراجعة النصوص الخاصة، وأعني بها تلكم النصوص التي ترتبط بموضوع البحث مباشرة.
2- وفي حالة عدم العثور على نص خاص يستفاد منه حكم المسألة يرجع إلى النصوص العامة، وهي ما يصطلح عليه فقهياً العمومات والاطلاقات التي تشمل بعمومها أو إطلاقها موضوع البحث. والنصوص الشرعية بفئتيها الخاصة والعامة هي من الكثرة بحيث تغطي كل ما يحتاجه الفقيه في مجال استنباط الأحكام الشرعية، وعلى هذا لا نكون بحاجة لمثل هذا الأصل ولا تصل النوبة إليه، ويلاحظ عليه ثانياً: إن الفلسفة تجري مثل هذا الأصل في مجالات بحثها، وهي الأمور التكوينية ويعني بالأمور التكوينية هنا الأشياء الممكنة التي لها قابلية الاتصاف بالوجود والاتصاف بالعدم، وقد عبروا عنها في هذا السياق بالحوادث، والولاية – بجميع جزئياتها – هي من التشريعات التي لا مجال لإجراء المبادئ الفلسفية عليها"(12) .
ثانياً: النزعة التاريخية
لا تخفى أهمية البعد التاريخي في البحث الفقهي، بل على مستوى عملية الاستنباط نفسها، بما للبعد التاريخي من تأثير في فهم النصوص الشرعية والتعرّف على مصاديق الحكم الشرعي ، فضلاً عن المسارات العلمية والمراحل التاريخية لمسائل البحث الفقهي.
وإذا كان هناك من غفل عن هذا البُعد فإن هذا الإغفال مما انعكس في طبيعة تفكيره والمعطيات التي تمخَّضت عن عملية التفكير هذه.
وعلى أية حال، فقد اعتنى الشيخ الفضلي باهتمام بالغ بالبعد التاريخي إن على المستوى العلمي التقني أو على مستوى عملية الاستنباط نفسها، بما يُعبَّر عن نزعة تاريخية واضحة في منهجه الفقهي.
فعلى المستوى الأول: يلاحظ الباحث قدرة الشيخ الفضلي على التتبع لموضوعات بحثه والتحقيق في جذورها التاريخية ومساراتها ومراحلها.
وهذه المزّية إحدى أهم الملامح الرئيسة للبحث عند الشيخ الفضلي عموماً، والبحث الفقهي على وجه الخصوص.
وهناك عدد مهم من الإشارات يدل على هذه المزيّة، يمكن أن نشير إلى بعضها:
1- وقع البحث عند الفقهاء في دلالة قوله تعالى: {وأنزلنا من السماءِ ماءً طهورا}/[الفرقان: 48]، إذ ادعي أن لفظ (الطهور) دال على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره.
وبغض النظر عن كبير الفائدة في مثل هذا البحث، لوضوح الحكم في كون الماء طاهراً ومطهراً لغيره والاتفاق عليه عند المسلمين، فقد أشار الشيخ الفضلي إلى "إن أول من أدخل هذا المعنى الفقهي الاصطلاحي للكلمة عالم المعاجم اللغوية هو ثعلب (أحمد يحيى النحوي الكوفي) وعنه حكي ومنه أُخذ"(13) .
2- في مسألة اشتراط الحياة في المجتهد (المقلَّد) لاحظ الشيخ الفضلي إن هذه المسألة لم يثر البحث فيها إلاّ في القرن العاشر وذلك عندما صدَّر الشهيد الثاني بحثه في هذه المسألة وأشار إلى شرط الحياة في المجتهد.
هذا بالنسبة للوسط العلمي الشيعي الاثني عشري، وأما بالنسبة للوسط العلمي السني، فقد لاحظ أن أول إشارة لذلك – ربما – تكون في ما ذكره الفخر الرازي (ت606هـ)، مما يدخل في هذه المسألة.
3- في مسألة وجوب تقليد الفقيه الأعلم إدّعي إنها مما تسالم الشيعة عليه، ونسبت هذه الدعوى إلى السيد المرتضى مما ورد في كتابه الأصولي (الذريعة)، ولذلك ادعى أن القول بجواز تقليد الفقيه غير الأعلم قول متأخر إلى ما بعد عصر الشهيد الثاني.
وللشيخ الفضلي رأي في هذه الدعوى، إذ من خلال تتبعه التاريخي لهذه المسألة أثبت أن القول بجواز تقليد الفقيه غير الأعلم قديم وليس متأخراً إلى ما بعد الشهيد الثاني، وإن ما قيل عن التسالم عند الشيعة على وجوب تقليد الأعلم كما نسب إلى السيد المرتضى غير صحيح، إذ راجع الشيخ الفضلي نسخة قديمة نسخت عن نسخة يرجع تاريخها إلى سنة (1098هـ)، ولم يرد فيها ما يؤكد هذه النسبة، بل ورد فيها ما يؤكد الخلاف الفقهي الشيعي على هذه المسألة، إذ جعل السيد المرتضى القول بتقليد الأعلم هو الأولى(14).
4- في مسألة (العربون) وتكييفه فقهياً على نحو يسوغ تملكه لو لم يتم البيع، لاحظ الشيخ الفضلي – في حدود متابعته التي وصفها بأنها ذات مساحة صغيرة وذلك تواضعاً – أنه لم يقف على من تعرض بالبحث والدراسة من فقهاء الشيعة مستقلاً أو على نحوٍ غير مستقل، سوى ما أشار إليه مما ذكره الشيخ الحر العاملي من أحاديث في كتابه (وسائل الشيعة) في باب (وجوب احتساب العربون من الثمن)(15).
5- تتبع الشيخ الفضلي ردود أفعال معظم فقهائنا وتعليقاتهم على رأيي الشيخ الكاشاني والشيخ السبزواري في الغناء، وربما حُمل عليهما لجهة عدم القول بحرمة الغناء على وجه مطلق.
وقد لاحظ الشيخ الفضلي أن أول من أنصفهما من فقهائنا المتأخرين هو السيد الخميني ومحاولة توجيه رأييهما ووضعه في سياقه الصحيح والدفع عماّ أسماه السيد الخميني من (الطعن عليهما بما لا ينبغي) في إشارة إلى الحملات والتعليقات غير العلمية(16).
كما لاحظ الشيخ الفضلي أن ما نسب إلى الشيخ الكاشاني من تأثره بالغزالي في مسألة (الغناء) واقترابه من رأيه، يرجع إلى تعرّف الشيخ الكاشاني على رأي الغزالي من خلال تعرّفه على كتابه
(إحياء علوم الدين) حيث عمد الشيخ الكاشاني إلى تأليف كتابه (المحجة البيضاء في إحياء الإحياء) وهو تهذيب لكتاب الغزالي(17).
ويشير الشيخ الفضلي إلى أن التشابه في الجوانب الفنية الذي يلمسه الباحث بين رأي الشيخ الكاشاني ورأي الغزالي هو الذي دعا البعض إلى القول بتأثر الكاشاني بالغزالي.
6- في مسألة (ولاية المرأة) للوظائف العامة، أشار الشيخ الفضلي من خلال تتبعه التاريخي إلى أن ما عرف باشتراط الذكورة أو الرجالية في المفتي كان من أبحاث أصول الفقه حيث يبحث هناك في موضوع الاجتهاد والتقليد. وقد نقل إلى الفقه ومسائله مع السيد كاظم اليزدي في كتابه (العروة الوثقى)(18).
7- في مسألة الفرق بين المنهج الأصولي والمنهج الإخباري في استنباط الحكم الشرعي، وضع الشيخ الفضلي القضية في سياقها الصحيح، وذلك من خلال التتبع التاريخي الذي دأب الشيخ الفضلي على اعتباره وملاحظته في عدد كبير من المسائل العلمية، ومنها هذه المسألة.
وكان المعروف في الفرق بين المنهجين كما صوَّره أنصار الفريقين، هو في وظيفة المجتهد نفسه، إذ يرى الإخباري إن وظيفته لا تتجاوز نقل مضمون الرواية بفتياه، وليس له أن يستند إلى مقدمات نظرية في إطار البحث عن الحكم الشرعي، فيما يعتمد المجتهد – من وجهة نظر الأصولي – على مقدمات نظرية لهذا الغرض وإنه لا يكتفي بما يكتفي به الإخباري. وللشيخ الفضلي رأي في هذه المسألة وبيان الفرق بين المنهجين إذ يقول: "... فالموجود في هذا الواقع التاريخي هو المنهج العلمي والعملي للفقه الذي جمع بين النظرية والتطبيق في آن واحدٍ: فالرواية إن كانت من حيث الدلالة نصاً في معناها فإنها لا تحتاج في استفادة الحكم منها إلى الاستعانة بالأدلة من قواعد أو سواها، وإن لم تكن من حيث الدلالة نصاً في معناها فأنها تفتقر لاستفادة الحكم منها إلى الاستعانة بالأدلة. وهذا الواقع المذكور تؤمن به المدرستان الإخبارية والأصولية"(19).
ولذلك يُلاحظ الشيخ الفضلي على ما ذكره أحد أبرز أعلام المدرسة الإخبارية وهو المحّدث الاسترابادي من اكتفاء المجتهد الإخباري بالتعاطي مع الرواية مباشرة وبأدنى تفكير، من أن >هذا الواقع الذي أشار إليه المحدث الاسترابادي لم يكن – في الواقع – هو القائم حين انبثاق المدرسة الإخبارية، وذلك أن الموجود على الساحة الفقهية آنذاك في مجال الوصول إلى الحكم واستفادته من النصوص الشرعية هو استخدام الوسائل النظرية بتطبيق القواعد والخلاف إنما هو في القواعد نفسها من حيث التطبيق<(20).
وأما على المستوى الثاني: وبما يتصل بالعملية الاجتهادية نفسها واستنباط الحكم الشرعي، فيمكن أن نشير إلى رأيه في (الغناء)، والبُعد التاريخي في استظهاره الأدلة وقراءتها لمحاولة اقتناص المعنى المراد منها.
وقد أشار الشيخ الفضلي إلى "أن لفظ الغناء المذكور في الروايات ينصرف بمعناه إلى الغناء المعهود حين صدور هذه الروايات، وهو العصر العباسي، والذي كان متعارفاً عليه من الغناء – آنذاك – هو الحفلات الغنائية التي كانت تُقام في بيوت الغناء ومجالس الطرب"(21).
ولذلك اعتبر الشيخ الفضلي من خلال متابعته التاريخية لتاريخ الغناء أن المحافل الغنائية هي القدر المتيقن، ولذلك فإن حمل الغناء "على سواه بما هو أوسع يفتقر إلى الدليل على الشمولية، وهو غير موجود هنا، حيث لا عموم ولا إطلاق في السؤال من الراوي، في الجواب من الإمام (ع)"(22).
| |
|
|
|
|
|





