|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 82198
|
|
الإنتساب : Aug 2015
|
|
المشاركات : 850
|
|
بمعدل : 0.25 يوميا
|
|
|
|
|
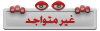

|
المنتدى :
منتدى القرآن الكريم
 براهين التوحيد في القرآن
براهين التوحيد في القرآن
 بتاريخ : 09-07-2022 الساعة : 09:01 AM
بتاريخ : 09-07-2022 الساعة : 09:01 AM

تنوعت البراهين الدالة على وحدانيته تعالى في القرآن الكريم، وهي متنوعة ومتفاوتة أيضا، في عمق استدلالاتها، دون أن يؤثر هذا التفاوت على سلامة الدليل وصحة الاستنتاج، لما تقدم أكثر من مرة، أنه يخاطب جميع الناس مبينا لكل فئة منهم ما يوصلهم إلى اليقين.
وسنتعرض هنا لبعض البراهين الواردة في القرآن الكريم، تشكل نماذج لما هو وارد فيه لإثبات التوحيد:
ألف: قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُون﴾[1].
تتضمن هذه الآية المباركة قياسا منطقيا، يتكون من مقدمات يقينية ومسلمة، لتنتج نتيجة يقينية أيضا، وهي كما يلي:
أما المقدمة الأولى: إن تعدد الآلهة يحتاج إلى دليل وبرهان، أما أصل وجود الواجب فقد قام الدليل عليه، وتقدم في طيات البحث أن معرفته فطرية، لا تحتاج إلى أكثر من التنبه والالتفات.
وأما المقدمة الثانية: انه لا برهان على وجود إله آخر، بل البرهان قائم على عدمه، لأن وجود أكثر من إله يستلزم تركيب كل منهما مما به الاشتراك، وما به التمايز، كما يستلزم محدودية الواجب وكلاهما مستحيل.
والذين يعبدون غير الله تعالى يستندون في ذلك إلى الأساطير وما توارثوه عن آبائهم، كما في قوله تعالى حكاية عن الكفار في جواب رسلهم، حين دعوهم إلى التوحيد، ﴿قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِين﴾[2], وقوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾[3].
والنتيجة: انه لا إله غيره تعالى، وهو الذي سيتولى حساب الكافرين.
باء: قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾[4].
تتضمن هذه الآية المباركة قياسا منطقيا أيضا، يشتمل على مقدمتين ذكرت إحداهما، وطويت الأخرى لوضوحها من المقدمة الصغرى، وهما:
المقدمة الأولى المذكورة: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
المقدمة المطوية: ولكنهما لم تفسدا
النتيجة: ليس فيهما آلهة إلا الله
والمهم في هذا القياس إثبات المقدمة الأولى وبيان الملازمة بين تعدد الآلهة وبين الفساد، لأن المقدمة الثانية ثابتة بالوجدان، ولذلك طويت.
تقرير الملازمة:
انه ثبت بالدليل والبرهان أن العالم واحد، كما ثبت أنه معلول، ومن حيث هو معلول يحتاج إلى علة تفيض عليه الوجود، إذ يستحيل أن يوجد نفسه بنفسه، لأن فرض كونه معلولا يعني حاجته وفقدانه وفقره، فالوجود مفاض عليه من غيره.
وثبت في محله أيضا أن المعلول الواحد لا يمكن أن يصدر إلا من علة واحدة، لأن فرض أكثر من علة له لا يخلو من أن يكون كل منهما علة تامة، ويستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، لزم أن يكون له وجودان، لاستقلال كل علة بأثرها، وهو خلف كونه واحدا.
وإما أن لا تستقل كل منهما بأثرها، ويكون الأثر منهما مجتمعين، فمعناه عدم كونهما علتين تامتين مستقلتين، ولازمه أن تشتمل كل منهما على نقص وفقدان، تحتاج إلى الأخرى لرفعه، وهو خلف كونهما واجبي الوجود، لأن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، واشتماله على الفقدان والحاجة من جهة، يعني اشتماله على جهة إمكانية، وهو خلف كونه واجبا.
هذا بالإضافة إلى أنه يستلزم التركيب في العلة، أي ان علة العالم مركبة من الإله الأول والثاني، لأن المفروض أنه لا استقلال لأحدهما بالتأثير، إذ المؤثر في الحقيقة مجموعهما، فهما معا علة تامة، وهو أيضا خلف ما ثبت من بساطة الواجب واستحالة التركيب فيه.
وقرر العلامة الطباطبائي هذا البرهان بوجه آخر، يستند إلى وحدة النظام في العالم, حيث قال:
(إنه لو فرض للعالم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتا متباينين حقيقة، وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم، فتتفاسد التدبيرات وتفسد السماء والأرض، لكن النظام الجاري نظام واحد متلائم الأجزاء في غاياتها، فليس للعالم آلهة فوق الواحد وهو المطلوب)[5].
جيم: قال تعالى: ﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾[6].
تشتمل هذه الآية المباركة على دليل هو عبارة عن قياس منطقي، وردت فيه النتيجة في البداية ورتب عليها المقدمات بصورة محذور، وحاصل المقدمتين:
الأولى: لو كان للوجود آلهة إلا الله لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعض الآلهة على بعض، وحصل التخاصم والتنازع بينهما، وحصل التباين في المخلوقات، واختل النظام في الكون وتحقق الفساد.
الثانية: ولكنه لا اختلال في نظام الكون ولا تباين بين المخلوقات.
النتيجة: انه لا إله إلا الله تعالى.
والمهم في هذا الدليل بيان المحاذير الواردة في المقدمة الأولى وبيان الملازمة فيه، بعد ملاحظة أنه ناظر إلى تدبير الكون وتصريف شؤونه، وحاصلها: أن من شأن الإله أن يختص بمخلوقاته، ويدبر شؤونها، ولما كان لكل إله مخلوقاته الخاصة كما يقتضيه معنى الألوهية، فمن غير الممكن أن يترك أمرها لسواه، يزاحمه في الخلق أو التدبير لأن ذلك مخالف لمقتضى ألوهيته، فإن تدبير كل منهما وإرادته مغاير لتدبير الآخر وإرادته، لأن ذلك ما يقتضيه تغايرهما في الوجود، إذ لو كانت إرادتهما وتدبيرهما واحدة، لزم ثبوت وجود واحد لهما، وهو خلاف الفرض.
مضافا إلى أن فرض اتحاد إرادتهما وتدبيرهما يستلزم أن يكونا علة تامة مجتمعين، لا أن يكون كل منهما مستقلا عن الآخر، ولازمه التركيب في الألوهية وهو مستحيل.
كما أن مقتضى ألوهية كل منهما وإرادته وتدبيره المستقل عن إرادة الآخر وتدبيره، يؤدي إلى تدافع الإرادتين وتضادهما، ولازمه تحقق الفساد، واختلال النظام في الكون، إذ لو فرضنا أن إرادة أحدهما تعلقت في خلق إنسان مثلا، وتعلقت إرادة الآخر بجعله فرسا لزم أن يكون المخلوق الواحد إنسانا وفرسا في آن معا، وهو مستحيل، لأن لازم ذلك نفاذ إرادة كل منهما، لفرض قدرته على ما يشاء لذاته، والنتيجة أن يكون كل منهما غالبا ومغلوبا في آن معا.
بقيت نقطة في المقام، وهي ما ربط الولد في الاستدلال، حيث صدرت الآية الشريفة بقوله تعالى:﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَد﴾ ورتب عليها وعلى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰه﴾ المحاذير المذكورة؟
والجواب: أن مقتضى التوالد أن يكون الولد من سنخ الوالد وطبيعته وحقيقته، فالإنسان مثلا لا يلد فرسا، أو حملا أو غيره، وكذلك العكس، فالإنسان يلد إنسانا، والفرس فرسا وهكذا، فالمولود من الإله من سنخه أيضا، يعني أنه مشتمل على صفات الإلهية وخصائصها، فلا بد أن يتمتع بما يتمتع به الوالد، من الخلق والتدبير ونفاذ الإرادة وغيرها، ولازمه تعدد الآلهة أيضا، فمحذوره نفس المحذور المذكور في الآية الشريفة.
ولا يخفى أن الآية تشير إشارة لطيفة إلى ابتلاء القائلين بأن لله تعالى ولدا بمحذور الشرك من حيث لا يشعرون.
دال: قال تعالى:﴿قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّٱبْتَغَوْاْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيل﴾[7].
تشتمل الآية المباركة على دليل آخر على التوحيد، من جهة أن الألوهية تقتضي الملك، وحب الملك والسيطرة من ثوابت الوجود، فإن كل كائن يسعى إلى الملك والسيطرة والتسلط، فمدلول الآية أنه لو كان آلهة إلا الله، لعمل كل منهم على تحصيل ما في يد غيره، والإستئثار به دون سواه، كما تفرضه طبائع الموجودات، ولازمه وقوع التنازع والتخاصم بينهم، الأمر الذي يؤدي إلى فساد الكون واختلال النظام فيه.
ومن الظاهر أن هذه الآية ناظرة إلى التعدد من جهة الملك والتدبير، وليست ناظرة إلى اختلاف الآلهة من جهة ذاتيهما، ولهذا عبرت عنه تعالى: ﴿ذِى ٱلْعَرْش﴾[8]، إشارة إلى هذا المعنى، ويمكن ترتيب القياس المنطقي لهذا البرهان المؤلف من مقدمتين، كما يلي:
الأولى: لو كان مع الله آلهة أخرى لنازعوه في الملك وفسد الكون.
الثانية: ولكن لا فساد في الكون ولا منازعة في الملك.
النتيجة: فليس معه آلهة أخرى كما يقولون.
والأدلة القرآنية على توحيده كثيرة جدا.
سماحة الشيخ حاتم إسماعيل (رحمه الله) [1] سورة المؤمنون، آية: 117
[2] سورة ابراهيم، آية: 10
[3] سورة الزخرف، آية: 22
[4] سورة الأنبياء، آية: 22
[5] الميزان في تفسير القرآن، ج17، ص267
[6] سورة المؤمنون، آية: 91
[7] سورة الإسراء، آية: 42
[8] سورة التكوير، آية: 20.
| |
|
|
|
|
|





