|
|
عضو فضي
|
|
رقم العضوية : 34252
|
|
الإنتساب : Apr 2009
|
|
المشاركات : 1,863
|
|
بمعدل : 0.31 يوميا
|
|
|
|
|
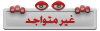

|
كاتب الموضوع :
الحوزويه الصغيره
المنتدى :
المنتدى الفقهي
 بتاريخ : 26-06-2011 الساعة : 05:30 AM
بتاريخ : 26-06-2011 الساعة : 05:30 AM
والذي يؤكد ماذكرناه انَّ التعبير بالعدول لا يُناسب التخصيص - والذي هو الاحتمال الاول - إذ انَّ العدول يستبطن وجود قاعدة كلية متبناة تقتضي حكماً معيناً إلاّ انَّ ثمة شيئاً أوجب العدول عن هذه القاعدة، والتخصيص ليس من هذا القبيل، وذلك لأنَّ المخصص لو كان متصلا فإنَّ حكم المسألة المستفاد من المخصِّص ثابت بنفس الخطاب المفيد للعموم، فليس من قاعدة تقتضي حكماً مغايراً وتكون المسألة الخارجة بالتخصيص مشمولة له أولا ثم تخرج بواسطة الدليل الخاص حتى يصدق العدول، إذ انَّ العموم من أول الأمر لا يشمل المسألة الخارجة بالمخصص المتصل، وأمَّا لو كان المخصِّص منفصلا فكذلك لا يكون التعبير بالعدول دقيقاً لو كان المراد منه التخصيص، إذ ان التعويل على الاطلاق أو العموم قبل الفحص عن المخصِّص أو المقيِّد غير صحيح، وذلك للعلم الإجمالي بوجودات مخصِّصات ومقيّدات منفصلة في الخطابات الشرعية، فمع الفحص والعثور على المخصِّص المنفصل لا يكون العمل بمقتضى المخصص أو المقيد عدولا عن العموم والاطلاق، وذلك لانّ الاطلاق وكذلك العموم لم يكونا مرادين بالإرادة الجدية من أول الأمر بل المراد الجدِّي منهما هو غير ما يقتضيه المخصِّص المنفصل.
وبهذا يتنقح ان لا قاعدة كلية مبتبناة تم العدول عنها في موارد التخصيص بل انَّ المخصِّص يثبت في عرض العموم والاطلاق وانما قد يتفق العثور على العموم قبل العثور على المخصّص وقد ينعكس الأمر فنعثر على المخصّص قبل العثور على العموم أو الاطلاق وحينئذ فما معنى التعبير بالعدول.
وأما الاحتمال الثالث فيناسبه التعبير بالعدول، وذلك لأنَّ القياس ضابطة عقلية كلية محددة المعالم لا يقال في موردها انَّ بعض مواردها خارج من أول الأمر بل انَّ كل ما يخرج عنها يكون عدولا عن مقتضاها إلى شيء آخر.
هذا ما يناسب سقوط الإحتمال الاول، وأما الإحتمال الثاني فهو أبعد من الإحتمال الأول، وذلك لأنَّ الإستحسان فيه بمعنى تقديم الكتاب والسنة على سائر الادلة، ولا نجد مناسبة للتعبير بالعدول لو كان هذا المعنى هو المراد، إذ انَّ هذا المعنى لا يعني أكثر من بيان الترتيب المرحلي للأدلة في مقام المرجعية والإستنباط للأحكام الشرعية.
والمتحصَّل انَّ حمل التعريف على الدقة يقتضي كون المراد منه ما ذكرناه وهو الخروج عن القاعدة الكليَّة المستلهمة بواسطة القياس في موارد وجود الدليل الخاص من الكتاب والسنة، وهذا ما تؤكده مقتضيات القياس، إذ ان القياس العقلي لا يفرق بين مسألة واخرى بل يُعطي ضابطة كلية لنظائر المسألة المقيس عليها إلاّ انَّ المجتهد يعدل عمَّا يقتضيه القياس بسبب وجود الدليل الخاص من الكتاب والسنة.
والذي يُعزِّز ما استظهرناه من التعريف ما نقل عن البزودي - وهو من الاحناف - قال: ان الإستحسان هو (العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه).
والمناسب لما ذكرناه هو قوله (أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه) حيث اعتبر المعدول عنه هو القياس وليس هو دليل آخر كعمومات الكتاب والسنة.
ثم انَّ هذا التعريف أوسع دائرة من التعريف السابق حيث جعل الموجب للعدول عن القياس مطلق الدليل الأقوى، فلو اعتبرنا انَّ الإجماع وكذلك المصالح المرسلة أقوى دليليَّة من القياس كان ذلك موجباً للعدول عما يقتضيه القياس، وكذلك لو كان هناك قياس أقوى دليليَّة من قياس آخر فلابدَّ من العدول عن القياس المرجوح بمقتضى الإستحسان، إلاّ انَّ هذا التعريف لم يُشر إلى ماهي الضابطة لتشخيص اقوائية أحد القياسين على الآخر، والمحتمل في ضابطة الأقوائية أحد امور:
الأمر الاول: مناسبة القياس الأقوى للمصلحة.
ولو كانت هذه هي الضابطة لما صحَّ عدُّ الإستحسان دليلا برأسه، فهو حينئذ يرجع إلى المصالح المرسلة فهي المائز - بناء على هذا الاحتمال - بين القياس الأقوى من القياس الأضعف، وهذا ما يُوجب استبعاد هذا الإحتمال، إذ انَّ الظاهر منهم هو اعتبار الإستحسان دليلا مستقلا في عرض الأدلة الاخرى.
الأمر الثاني:مناسبته لسدِّ الذرايع أو العرف وهذا الإحتمال أيضاً ساقط لعين ماذكرناه في الأمر الاول.
الأمر الثالث: انَّ الضابطة في أقوائية قياس على آخر هو الذوق وملائمات الطبع، وهذا الإحتمال هو المتعين، إذ لا يرد عليه الإشكال الوارد على الاحتمال الاول والثاني، كما لا يتصوَّر ان تكون ضابطة الاقوائية هو موافقة القياس الأقوى للكتاب والسنة والإجماع، إذ انَّ ظاهر التعريف هو انَّ الدليل على حكم المسألة هو أحد القياسين لا غير، إلاّ انَّه لمَّا كان أحد القياسين منافياً لما يقتضيه الآخر كان ذلك مستوجباً للبحث عن الأقوى منهما.
هذا بالاضافة إلى انَّ الثالث من الامور المحتملة متناسب مع مجموعة من التعريفات المذكورة للإستحسان كما بينا ذلك.
المعنى الرابع: ما نُقل عن الشاطبي من المالكية انَّ الإستحسان هو (العمل بأقوى الدليلين).
ولم نتبين المراد من هذا التعريف، فهل المراد منه هو إعمال الإستحسان لتشخيص ماهو الدليل الأقوى أو انَّ المراد من الإستحسان هو نفس الأخذ بالدليل الأقوى والأقوائية تثبت بواسطة اخرى غير الإستحسان، فنفس الأخذ بما يقتضيه الكتاب الكريم وطرح ما يقتضيه الخبر الواحد المنافي هو الإستحسان، أو انَّ الإستحسان معناه هذه القاعدة الكليَّة وهي كلما تعارض دليلان فالحجيَّة تكون في طرف الأقوى منهما، وهذا المعنى أيضاً لا يشخِّص لنا ضابطة الأقوائية.
فبناءً على الإحتمال الثاني لا يكون الإستحسان من الأدلة على الحكم الشرعي وانما يكون مجرَّد اصطلاح يُطلق على هذه الحالة التي يعمل فيها المجتهد بالدليل الأقوى.
وأما الإحتمال الثالث: فهو خلاف ظاهر التعريف، إذ انَّ هذه القاعدة لا تعدو إما ان تكون قاعدة عقلية منشاؤها إدراك العقل لاستحالة ترجيح المرجوح واستحالة التخيير بين المرجوح والراجح، وإمّا انَّها قاعدة مستفادة من الشرع أو من دليل آخر، وإطلاق عنوان الإستحسان عليها مجرَّد اصطلاح وهو ينافي دعوى دليليته على الحكم الشرعي، ولو سلمنا استفادتها من الإستحسان فهذا لا يقتضي أكثر من كونها من موارد ما يكشف عنه الإستحسان لا أنها هي الإستحسان نفسه، وحينئذ لا يصلح تعريف الإستحسان بها فلابدَّ من الْتماس تعريف للإستحسان لو كان هذا الإحتمال هو المتعيَّن، وهذا ما يؤكد سقوط هذا الإحتمال، على انَّه لا معنى محصَّل من هذا الإحتمال، وذلك لأن الظاهر من التعريف انَّ المجتهد إنَّما يلجأ للإستحسان في حالة تعارض الأدلة مع إحراز دليلية كل واحد منهما على الحكم الشرعي لولا التعارض، وحينئذ لا معنى لأن يُقال خذ بما هو الأقوى منهما، لان ذلك لا يعالج المشكلة، فهو أشبه بما لو سألك سائل عن أي الطرقين أسلك وكان غرضه التعرُّف على الطريق الاقرب فتجيبه بقولك (اسلك أقرب الطريقين) فهنا لا يكون السائل قد تحصَّل على الجواب الناجع، لأنَّه انَّما يسأل عن الطريق الأقرب.
نعم لو كان يعلم بالطريق الأقرب إلاّ انَّه لا يعلم أهو ملْزَم بسلوك الطريق الاقرب أو هو مخير مثلا فإنَّ الجواب بالقول (اسلك الطريق الأقرب) يكون ناجعاً، إلاّ انَّ ذلك خلاف الظاهر من مرجعية الإستحسان في ظرف التعارض، لأن الظاهر انَّه لا يُلجأ للإستحسان للتعرُّف على هذه القاعدة فحسب بل يُلجأ اليه لتشخيص الدليل الأقوى من الدليل الأضعف.
ومن هنا يكون المتعيَّن من الإحتمالات هو الإحتمال الأول، وبهذا يكون تعريف الإستحسان - بناء على هذا الإحتمال - هو المشخِّص للدليل الأقوى الذي يلزم العمل به، فيكون التعريف من قبيل التعريف بالفائدة والنتيجة، فهذا وان كان خلاف الظاهر من التعريفات إلاّ انَّ ذلك مألوف في التعريفات التي يكون الغرض منها إعطاء صورة عن المعرَّف كما يقال في تعريف الخمر انَّه المسكر، فهو تعريف بما ينتج عنه.
والمتحصَّل انَّ هذا الإحتمال وان كان خلاف الظاهر من التعريف إلاّ انَّه لمّا كان الإحتمال الثاني - والذي هو أقرب بحسب الصياغة اللفظية للتعريف - بعيد جداً كما ذكرنا والإحتمال الثالث ساقط لابتلائه بما ذكرناه من إشكال فيدور التعريف بين الإجمال وعدم انفهام معنى محصل له وبين الإحتمال الأول، والظاهر تعيُّنه لمناسبته مع تعريفات اخرى ومناسبته كذلك مع مرجعية الإستحسان في مقام التعارض.
ومع تمامية هذا الإحتمال يبقى السؤال عن الآليَّة المعتمدة للإستحسان لتشخيص الدليل الأقوى والتي هي جوهر الإستحسان، حيث قلنا انَّ هذا التعريف - بناء على الإحتمال الاول - لا يكشف لنا سوى عن النتيجة المترتبة على الإستحسان، وهي تشخيص الدليل الأقوى وأما الآلية المعتمدة لذلك فلابدَّ من استفادتها من مورد آخر.
وهنا مجموعة من الإحتمالات نوردها لغرض البحث عمَّا هو المتعيَّن منها:
الاحتمال الاول: إنَّ الآلية المعتمدة لتشخيص الدليل الأقوى هو الكتاب المجيد أو السنة أو العقل القطعي والظني أو مناسبة أحد الدليلين لما تقتضيه المصلحة العامة أو مناسبة أحدهما للمرتكزات العرفية أو تناسب أحدهما لسدِّ الذرايع المفضية للحرام فهو حينئذ يكون الاقوى أو تناسب أحدهما لفتح الذرايع المفضية للواجب فهو الاقوى من الدليل الفاقد لهذه الخصوصية.
الاحتمال الثاني: ملائمة أحد الدليلين للطبع أو منافاة أحدهما للمذاقات العامة فيكون ما يقابله هو الأقوى.
الاحتمال الثالث: هو مجموع هذه المرجحات.
أمَّا الترجيح بالكتاب أو بالسنة أو بالعقل أو بالمصلحة أو بسدِّ الذرايع أو فتحها أو بالمرتكزات العرفية فمن غير المناسب أن يُطلق عليها الترجيح بالإستحسان بل المناسب ان يقال ترجيح أحد الدليلين بالكتاب أو بالعقل وهكذا.
وما قد يقال انَّه مجرَّد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
نقول انَّ هذا الكلام صحيح إلاّ اننا لا نُحرز انَّ ترجيح أحد الدليلين بالكتاب مثلا يُصطلح عليه بالاستحسان حتى نقول لا مشاحة في الاصطلاح وانما نبحث عن ان مصطلح الاستحسان على أيِّ شيء يطلق، وحينئذ لابدَّ من ملاحظة الإعتبارات والمناسبات بين المصطلح والمصطلح عليه، ومن الواضح عدم التناسب بين ترجيح أحد الدليلين بالكتاب المجيد وبين مصطلح الإستحسان.
وأما الاحتمال الثالث فيضعفه ما نجده في كلمات القوم من عدم انحصار الترجيح وتشخيص الاقوى بالإستحسان، فلو كان الاحتمال الثالث هو المتعين لكان جامعاً لتمام المرجحات وهذا ما لا يمكن قبوله لملاحظة انَّ الاستحسان في كلماتهم يكون في عرض مرجحات اخرى وفي حالات يكون في طولها مما يُعبِّر عن انَّ الإحتمال الثالث ليس هو المقصود.
ومن هنا يتعين الإحتمال الثاني، إذ هو الذي لا يرد على الإشكال الوارد على الإحتمال الاول كما لا يرد عليه الإشكال الوارد على الإحتمال الثالث، فمن المناسب جداً ان يُقال حين ترجيح أحد الدليلين بما يُلائم الطبع والمذاقات العامة من المناسب انَّ يقال انَّ الترجيح تم بالإستحسان، على انَّ هذا الإحتمال هو المناسب لبعض التعريفات المذكورة للإستحسان.
ثم انَّه لو افترضنا جدلا ان الإحتمال الثالث هو المتعيِّن لكان علينا ان نمارس عملية الاستذواق لغرض تشخيص الدليل الاقوى ولو في الحالات التي لا يكون معها مرجح آخر، كما لو تعارض خبران ولم يكن ثمة مرجح من المرجحات الاخرى فإنَّ علينا ان نلاحظ ماهو الدليل المناسب لمقتضيات الذوق وملائمات الطبع، وهذا هو المستفاد مما ذكره السرخسي في مبسوطه، حيث ذكر ان من تعريفات الإستحسان هو (طلب السهولة في الاحكام مما يبتلي به الخاص والعام) وكذلك ما نقله عن بعض من انَّ الإستحسان هو (الأخذ بالسماحة وانتفاء مافيه الراحة) (والأخذ بالسعة وابتغاء الدعة)، فإنَّ هذه التعريفات تعبِّر عن انَّه يحوم في حمى الإحتمال الذي رجَّحناه أو يكون الإستحسان متضمناً للمعنى الذي ذكرناه.
وأما احتمال ان تكون الآلية لتشخيص الدليل الأقوى هو مجموع المرجحات باستثناء ما ذكرناه في الاحتمال الثاني فهو وان كان معقولا إلاّ انَّه يتنافى - كما ذكرنا - مع عدِّ الإستحسان مرجحاً في عرض المرجحات الاخرى وفي حالات يكون في طولها مما يؤكد عدم إرادة هذا الإحتمال.
المعنى الخامس: وهو ما نُقل عن المالكيَّة من انَّ الإستحسان هو (الإلتفات إلى المصلحة والعدل).
وهنا لم يُحدِّد لنا التعريف متى يلجأ المجتهد للإلتفات إلى المصلحة والعدل، وهل انَّ الالتفات لذلك يكون في ظرف التعارض بين الأدلة، فيكون الإستحسان من وسائل علاج التعارض أو ان الإلتفات يكون ابتدائياً، بمعنى انَّه يكون وسيلة للكشف عن الحكم الشرعي فيكون في عرض الأدلة الاخرى، أو انَّ الإلتفات يكون لغرض محاكمة الأدلة الشرعية والعقلية وغيرها فما كان منها مناسباً للمصلحة والعدل فهي صالحة للدليلية، أما مع منافاتها للمصلحة والعدل فهي لا تصلح للدليلية والكاشفية عن الحكم الشرعي فتكون للإستحسان فوقية على سائر الأدلة، إذ هو المشخص - بناء على هذا الإحتمال - للحجَّة منها من غير الحجة حتى في ظرف عدم التعارض.
على انَّ التعريف لم يُشخِّص لنا مرتبة المصلحة الموجبة للترجيح لو كان الإحتمال الاول هو المراد، كما انَّه لم يُبيِّن لنا مقدار المصلحة المؤثرة في الكشف عن الحكم الشرعي لو كان الإحتمال الثاني هو المقصود، كما انَّه لم يُوقفنا على ماهية وحدود المصلحة الموجبة لثبوت الحجية لبعض الأدلة وانتفائها عن أدلة اخرى لو كان الإحتمال الثالث هو المراد.
ومن هنا لا ندري ماهو العلاج في حالة تعارض المصلحتين أو تزاحمهما وبأيِّ وسيلة يتوسَّل المجتهد لترجيح احدى المصلحتين، ثم ماذا لو تعارض أو تزاحم العدل مع المصلحة بأن كان أحد الدليلين مناسباً للمصلحة وكان الآخر مناسباً لمقتضيات العدل أو كان أحد الفعلين مناسباً للمصلحة والآخر للعدل ولم يكن ثمة مرجح من المرجحات الاُخرى.
مثلا لو كان هناك رجل يحرق في كل ليلة بيتاً من بيوتات البلدة وكان قطع مادة الفساد الذي يُحدثه هذا الرجل يتوقف على حبس مجموعة من الرجال وتعذيبهم لغرض التعرُّف على الجاني منهم ولم يكن ثمة وسيلة اخرى لقطع مادة الفساد.
فهنا يكون حبس هؤلاء الرجال وتعذيبهم متناسباً مع المصلحة العامة إلاّ انَّه مناف للعدل، إذ لا إشكال انّ حبس غير الجاني وتعذيبه من الظلم، فهذه الحالة لا يجيب عليها التعريف المذكور أيضاً.
على انَّه يمكن الإيراد على التعريف بأن الإستحسان لا يكون - بناء عليه - دليلا مستقلا بل هو راجع إلى المصالح المرسلة والى ما يُدركه العقل من حسن العدل وقبح الظلم، وحينئذ لا يكون الإستحسان إلاّ تكثيراً للمصطلحات بلا مغزى، وهذا يتنافى مع الصناعة العلمية، هذا بالإضافة إلى انَّ الظاهر من كلمات الاُصوليين وفقهاء القوم انَّ الإستحسان دليل مستقل في عرض الأدلة كالمصالح المرسلة والدليل العقلي وليس هو مصطلح ثان للمصالح المرسلة والدليل العقلي.
ومن هنا يكون التشكيك في دقة هذا التعريف كبيراً جداً.
هذا تمام الكلام في معنى الإستحسان، ولا بأس ببيان الأدلة التي استدلَّ بها على حجية الإستحسان.
ذكر السيد الحكيم في كتابه الاصول العامة انَّه استدلَّ على ذلك بآيتين من الكتاب المجيد وبرواية من السنة الشريفة وبالإجماع، ونحن نعرض لهذه الأدلة تباعاً.
الدليل الاول: قوله تعالى (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) ([1]).
وتقريب الإستدلال بهذه الآية الكريمة لصالح القول بحجية الإستحسان، انَّ الله تعالى امتدح عباده اللذين يتبعون أحسن القول، وهذا ما يُعبِّر عن حجية الإستحسان وإلاّ لما امتدح الله تعالى عباده المتصفين بالعمل بالإستحسان.
وقبل الجواب عن الإستدلال بالآية الشريفة نقول: انَّ المراد من عنوان الأحسن يحتمل ثلاثة احتمالات:
الإحتمال الأول: انَّه عنوان اضافي نسبي، وحينئذ يكون معنى الآية هو حجية كل قول أو رأي إذا اُضيف ونُسب إلى رأي آخر كان أحسن منه بقطع النظر عن كون القولين واجدين للحجيَّة في نفسيهما أو لا، فمحض الأحسنية هي المناط في ثبوت الحجية للقول المتصف بها.
وواضح انَّ هذا الإحتمال غير مراد جزماً، إذ من غير المعقول ان يكون القول أو الرأي غير واجد للحجية وبمجرَّد ان يُضاف إلى رأي آخر ويتفوق عليه نسبياً يكون ذلك موجباً لاتصافه بالحجيَّة، فالرأي حينما يكون منافياً لنظر الشارع لا يكون رجحانه على رأي آخر مناف أيضاً للشارع موجباً لثبوت الحجيَّة للرأي الراجح وإلاّ لما صحَّ ان تكون للشارع متبنيات خاصة تثبت بموجبها حجية بعض الأقوال وعدم حجية أقوال اخرى، إذ انَّ الاقوال التي لم تثبت لها الحجيَّة متفاضلة بلا ريب، وحينئذ يكون الافضل منها حجة يلزم التعبُّد به وهذا خلاف بناء الشارع على عدم حجيتها، هذا لو كان المراد من الأحسنية هو الأحسنية الواقعية وإلا لو كان المراد من الأحسنية هو الأحسنية بنظر كل أحدد للزم الهرج والمرج، إذ انَّ الأحسنية بهذا المعنى تخضع لعوامل نفسية وملاحظة المصالح الشخصية وهي متفاوتة من شخص لآخر ومتزاحمة في غالب الأحيان، وعندئذ يجرُّ كل واحد النار إلى قرصه، وتكون لغة الغاب هي المحكمة في المجتمعات وبها يختلُّ النظام، وهذا ما يورث الجزم بعدم إرادة الآية الشريفة لهذا المعنى.
[1]- سورة الزمر: 18.
يتبع
| |
|
|
|
|
|





