|
|
عضو جديد
|
|
رقم العضوية : 71681
|
|
الإنتساب : Apr 2012
|
|
المشاركات : 62
|
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
|
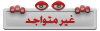

|
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
 أثر الإمام الخميني على التوازن الدولي في العالم
أثر الإمام الخميني على التوازن الدولي في العالم
 بتاريخ : 03-04-2012 الساعة : 05:42 PM
بتاريخ : 03-04-2012 الساعة : 05:42 PM
لقد استحدثت الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الراحل الخميني وعيا جديداً بالإسلام بعد قرن من التجاهل لدوره السياسي.. ومنذ انتصار الثورة والكلام مستمر حول إنشاء نظام دولي جديد. وتحاول القوى الاستعمارية استباق الأحداث وتطويق طريق الصحوة الإسلامية، ولكن لا تراجع للإسلام عن احتلال موقعه المتقدم وتغيير موازين القوى العالمية كما يتبين من المقال التالي:
الإسلام رسالة عالمية ورؤية كونية، فإذا عطل عن دوره العالمي فمعنى ذلك ليس فقط انحرافا فيه عن الخط القويم، بل معنى ذلك أيضاً أن العالم يعيش حالة من اللاتوازن، فاسحة المجال لقيام علاقات وتوازنات دولية أسّهما الرعب والخوف والظلم والعدوان والهيمنة. وبتغييب الإسلام من الخارطة السياسية متمثلاً بسقوط الخلافة، وانهيار أخريات الدول الإسلامية العثمانية والصفوية والمغولية، التي بغض النظر عن أساليبها الجائرة والمستبدة، بقيت شوكة تمنع تكامل النظام الاستعماري الصاعد. فتآمروا عليها منظمين رؤيتهم للقيام بذلك بما اصطلحوا عليه بــ "المسألة الشرقية" و "الرجل المريض". يقول الإمام الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية": "جزأ الاستعمار وطننا، وحوّل المسلمين إلى شعوب. وعند ظهور الدولة العثمانية كدولة موحدة سعى المستعمرون إلى تفتيتها. لقد تحالف الروس والانكليز وحلفاؤهم وحاربوا العثمانيين ثم تقاسموا الغنائم كما تعلمون. ونحن لا ننكر أن أكثر حكام الدولة العثمانية كانت تنقصهم الكفاءة والجدارة والإلهية، وبعضهم كان مليئا بالفساد، وكثير منهم كانوا يحكمون الناس حكماً ملكياً مطلقاً. ومع ذلك كان المستعمرون يخشون أن يتسلم بعض ذوي الصلاح والأهلية من الناس وبمعونة الناس منصة قيادة الدولة العثمانية على وحدتها وقدرتها وقوتها وثوراتها، فيبدد كل آمال الاستعماريين وأحلامهم".
إن تغييب الإسلام، أو على الأقل تعبيراته السياسية، كان شرطاً أولاً وأساسياً لنجاح المشروع الاستعماري والامبريالي وسيادته عالمياً، إذ أصبح واضحاً الآن أن الحروب التي شنت باسم الحروب الصليبية، والتي بقي المسلمون على مبدأيتهم بتسميتها بحروب الفرنجة، كانت بدايات الخروج الاستعماري محققا انتصاره الكامل في القرنين التاسع عشر والعشرين. فالنظام الدولي في جوهره هو النظام الاستعماري الذي هو المنظم الحقيقي لأعمال السلم والحرب، التحالف والعدوان، التبادل والمقاطعة، ولكل الأعراف الدبلوماسية وعلاقات الدول وقوانين النقد والتجارة وانتقال العلوم والخبرات والتنظيمات والقيم. فالقوانين الدولية وهرم الهيمنة الذي تعكسه، وطريقة أداء النظام الدولي ما هو في جوهر عمله وغاياته سوى التتويج الطبيعي للنظام الدولي الاستعماري الذي أسسته الدول الغربية. فغياب الإسلام عن المسرح الدولي شرط لنجاح المشروع الاستعماري، وعودته إليه مؤذناً بنفيه وتعطيله. فالإسلام، شاء المعاندون أم أبوا هو ميزان الحق في الدنيا.. إنه دين الفطرة والنزعة العقلية الحقة. فهو يرفض العدوان أو قبول العدوان.. يرفض الظلم أو قبول الظلم انطلاقاً من مبادئه وقيمه، لا انطلاقاً من حسابات وضعية وقياسات مرحلية. فهو العقيدة الوحيدة التي لم تجعل لنفسها صنماً تعبده. أما العقائد الأخرى فقد عبدت مرة الحجارة ومرة الحيوان.. مرة المال ومرة الفرد.. مرة العقل ومرة الهوى وغيرها. أما الإسلام فهو العبودية لله الذي "وضع الميزان" الله الذي هو الحق.. الله المنزه الذي "لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس" الذي لا غاية له فينتهي ولا آخر له فينقضي"، "هو الظاهر على الأرض بسلطانه، وهو الباطن لها بعمله، والعالي على كل شيء منها بجلاله".
هذه العبودية لله الذي هو الحق، جعلت الإسلام العقيدة الوحيدة التي لا تربط بين الإيمان بالحق وموازين القوى وحسابات الأرباح والخسائر. لذلك عندما كتب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى طواغيت زمانه يدعوهم للإسلام، ثم عندما خرج المسلمون ـ على قلتهم وضعفهم ـ ليحاربوا القوى العظمى في عصرهم، فإن ذلك لم يتم بعد امتلاك القوة المادية أو الكثرة العددية. فقد قبل الإسلام حينذاك النزال وانتصر فيه رغم أن كل الشروط الموضوعية والمادية والحربية كانت تقف بالضد من انتصارهم. فالحق والشرع عند الإسلام ليس الدفاع عن الأنا، بل الدفاع عن كلمة الله التي هي ميزان العدل بين البشر باختلاف ألوانهم ومشاربهم ومآكلهم وحضارتهم.
وخلاف ذلك حدث ويحدث في الطرف الآخر. فعندما أحست أوروبا بالضعف يدب إلى الكيان الإسلامي، بعد أن بدأت آثار استيلاء الملك العضوض تعطي آثارها السلبية في الديار الإسلامية، انقضت على الأقاليم الإسلامية الواحد تلو الآخر. فعملية جس النبض وبدء الهجوم، لم تبدأ في المشرق الإسلامي مع ما أسموه بالحملات "الصليبية"، بل بدأت في الأندلس. ففي العام 1037م بدأ ما اصطلح عليه إعادة فتحReconquista و"تنصير" الأندلس وقتل وملاحقة المسلمين واليهود على حد سواء. فنجح فرديناد كاستيل في الاستيلاء على المناطق في شمال أسبانيا والبرتغال. وفي العام 1085م سقطت طليطلة على يد الفونس السادس.. وبعدها بعقد واحد، وبعد أن تأكد الفرنجة من ضعف البنية الإسلامية بدأت الحملة "الصليبية" الأولى في العام 1095، وبعدها بعدة سنوات (1099م) استولى الفرنجة على بيت المقدس.
والمغول أيضاً أحسوا بهذا الضعف.. ولا يخفى أن تحالفاً موضوعياً وفعلياً قد قام بين الفرنجة والمغول. فسقطت بغداد (دار الخلافة آنذاك) في العام 1258م ثم حلب، وتوجهت جيوش المغول نحو بيت المقدس، حيث كانت جيوش الفرنجة تضغط على طول الساحل. وصحيح أن حملات الفرنجة والمغول قد صدت أو احتوت في نهاية المطاف. فمخزون مقاومة الأمة الموروث تكفل بذلك.. لكن الصحيح أيضاً أن هذه الهجمة لم تهزم كلياً ــ كما هو الرأي السائد ــ بل كانت نتيجتها التعادل أو التعطيل المؤقت.. فالهدف لم يكن بيت المقدس، إلا بمقدار ما يعبر الاستيلاء عن بيت المقدس عن الاستيلاء والسيطرة على العالم.
وبناء على ما تقدم، لم تمثل رحلات "الاستكشاف" التي تلت فشل الفرنجة في اختراق الخطوط الإسلامية سوى عملية التفاف لتطويق العالم الإسلامي من الخلف فترافقت حملات ماركوبولو (1298م) مع انتهاء آخر الحملات "الصليبية". وترافق وصول كولومبوس صدفة إلى أمريكا (1492م) ــ وهو يسعى للوصول إلى الهند للالتفاف على العالم الإسلامي من الخلف مع سقوط غرناطة (1492م) آخر قلاع المسلمين في الأندلس. وقبل ذلك (1488م) وصل البرتغاليون إلى رأس الرجاء الصالح في علمية التفاف على أفريقيا للدخول في قلب البحار الداخلية الإسلامية.
وهكذا، وبعد أن انتهى تطويق العالم الإسلامي أصدر الباب الكسندر السادس في عام 1493م إعلاناً يقسم فيه العالم بين أسبانيا والبرتغال.
أما المسلمون فإنهم لم يجدوا أمامهم طوال القرون الممتدة إلى القرن التاسع عشر سوى جناح أوروبا الشرقي الجنوبي الرخو للرد على هذا الضغط التاريخي الفرنجي فوصلوا إلى النمسا. تلكن هذه المحاولة على جرأتها ستهزم في النهاية. فعوامل الظلم والتمزق والملوكية والاستغلال قد استشرت في الأمة.. مما أفقدها الكثير من حيويتها وقدراتها على تجديد طاقاتها وثقتها بنفسها وبإيمانها، وهي الشروط اللازمة للتصدي لهذه القوة الصاعدة التي استولت على كل مكتسبات وموجودات التاريخ والبشرية والقارات الخمس. لذلك يصح ما يقوله موريس لومبارد عندما رسم صورة للمراحل التاريخية تزامنت فيه "النهضة" الأوروبية مع الانكفاء في المنطقة وكأن إبقاء المنطقة الإسلامية خاضعة، مفتتة، متناحرة منحطة هو شرط تاريخي بنيوي لتقدم الغرب وسيادته. إذا صحت هذه الرؤية، فمعنى ذلك أن العالم الإسلامي هو حجر الزاوية في التوازن الدول وتطور العلاقات بين الأمم على قاعدة العدل والتوازن لا على قاعدة الظلم والانحراف بل على قاعدة العدل والحق.
ودخل القرن العشرون مع هزيمة سياسية كبرى للمسلمين وسيطرة كاملة للنظام الاستعماري الذي أضفى على نفسه شرعية عالمية وأوجد لذلك منظمتين دوليتين.. الأولى بعد الحرب الأولى (عصبة الأمم) أوكلت لها مهمة تقسيم الديار الإسلامي بين القوتين العظميين حينذاك فرنسا وإنكلترا وبناء عالم جديد يقوم على الدول القومية ضمن شبكة دولية يقف فيها العمالقة يمسكون بكل شيء. ثم هيئة الأمم، بعد الحرب الثانية، والتي أعادت التنظيم بما يتناسب وصعود الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كقوتين عظميين والتي أضفت غطاء شرعياً منمقاً جميلاً لعملية الهيمنة الدولية، وغرست "إسرائيل" في قلب العالم الإسلامي، وأعطت للدول الصغرى بعض الحريات تستخدمها عموما لتأييد القوانين الأساسية لعمل النظام الدولي، فإن هي تمردت فالدول العظمى تسمك بقرار النقض الذي يجعل يدها فوق كل يد.
ووسط هذه الظروف طرح الإمام الخميني مشروع الحكومة الإسلامية. ظروف إن حكمت فيها الحسابات العقلية وموازين القوى السائدة لن تحكم على المشروع إلا بالفشل. لكن أسلوب الإمام اختلف عن كل ما عداه. فخطه هو الأقرب امتدادا لخط الرسالات السماوية التي سر النجاح فيها هو تحديد أصنام العصر بكل دقة. فالإسلام يبدأ بكل "لا" التي هي رفض أية عبودية إلا عبودية الله، وهو عنوان الحق المطلق. منهجه هو المنهج النبوي الذي يشخص بدقة أصنام عصره التي تقف عقبة في طريق الوصول إلى الله، إلى الحق والعدل المطلقين. هذا هو السر في نجاح الإمام فيما فشل فيه غيره. يقول في رسالته إلى حجاج بيت الله الحرام في (1403م): "لقد علمنا إبراهيم الخليل أن نضحي بأغلى وأعز ثمرات بحياتنا ثم نحتفل بتلك التضحية. إن إبراهيم مكسر الأصنام الأول وابنه العزيز سيد الأنبياء محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) مكسر الأصنام الآخر قد علما البشرية بأن الأصنام مهما كانت وكلما كانت يجب أن تكسر.. سواء كانت هياكل أو شمساً أو قمراً أو حيواناً أو إنساناً، وأي صنم أكبر وأخطر من الطواغيت على امتداد العصور. أليست القوى الكبرى في عصرنا أصناماً كبرى تدعو العالمين إلى طاعتها وتعظيمها وعبوديتها وتفرض عليهم سيطرتها بالمال والقسر والتزوير". فسمى القوى العظمى بالشياطين.. وشخص الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر، وسمى "إسرائيل" سرطاناً، وأوجد بسرعة منظومة من الأفكار تلخصها موضوعة المستكبرين والمستضعفين والتي صارت تلخص مجمل المعركة مع نظام التوازن الدولي القائم على الهيمنة والرعب والذي جوهره النظام الاستعماري.
وكانت انتصار الثورة الإسلامية ليس انتصاراً في الساحة الإيرانية، بل تحولاً عالمياً وتاريخياً. ها هو المستوى الأهم الذي تركزت عليه مخاوف الدول العظمى. وتحركت القوى العظمى وشبكة علاقاتها الدولية وحاصرت الجمهورية وأرادت وأدها بالحرب والمقاطعة وأعمال العزل والتخريب. وتحركت الجيوش لاحتلال مواقع أمامية درءاً لانتشار التجربة.. فتقدم الجيش السوفياتي واحتل أفغانستان سعياً للوصول إلى المياه الدافئة.. وصعد الجيش الإسرائيلي شمالاً وأحتل لبنان، وعبر بيغن في يومها عن وجود خطط لاحتلال الأردن والتقدم شرقاً. وتحركت القوى الدولية والمحلية ضمن همّ مركز يستهدف ضرب أي تحرك إسلامي. ووفرت ردود الفعل هذه على الأمة عقوداً طويلة من السنين، إذ هي أيقظت في الأمة إحساسها بوجودها وأهمية دورها وتحول الإسلام وقواه إلى معادلة سياسية أولى ليس على صعيد المنطقة الإسلامية فقط، بل على صعيد الدول الغربية والعالم أيضاً. وعليه تحقق ــ من الزاوية العملية والتاريخية ــ صالح عام للعالم الإسلامي في عملية تركيز أعداء الأمة هجومهم على الجمهورية وسعيهم لدمارها ومحاصرتها. إذ اضطرت القوى العظمى التي باتت شعوبها مترفة في حياتها إلى درجة لا تستطيع معها أن تدخل معارك كلاسيكية بلحمها ودمها، اضطرت على تشجيع أطراف محلية وإعطاءها مصادر القوة والخبرة، فصبت بذلك الزيت على النار. إذ بدل أن تنجح في القضاء على التجربة أوجدت خللاً في العلاقات الدولية، قد تكون له آثار إيجابية إذا ما نظر إليه بعين التاريخ والاتجاهات الكبرى. كما اضطرت القوى العظمى والدول القومية المعادية للإسلام للقبول بتيارات إسلامية إصلاحية في محاولة غير موفقة لعزل ما سمي بالتيارات المتطرفة، مما أسفر بالنتيجة إلى انتشار الرايات الإسلامية المرفوعة وتوسيع قواعد عملها والإقرار للإسلاميين، بما في ذلك بعض التيارات الثورية ــ كما في فلسطين وأفغانستان وغيرهما، بمساحات عمل لم تكن لتقرر لهم سابقاً، ولم يغير من أهمية هذه التطورات ــ من الناحية العملية والتاريخية ــ الموقف الودي أو اللاودي لعدد من هذه التيارات من الإمام والثورة الإسلامية. فالأهم رؤية هذه التطورات بالمنظور التاريخي، إذ إن انتشار الأطروحة الإسلامية ودخولها المعترك العملي هو المعرج الأول الذي عليه يمكن أن تدار الدفة في الاتجاهات الأصيلة والصحيحة.
وصمدت الجمهورية الإسلامية، وصارت حقيقة إقليمية وعالمية لا يمكن إلا التعامل معها.. وانسحب السوفيات من أفغانستان مع تصاعد رايات الجهاد الإسلامي، واندلعت الانتفاضة في فلسطين وفي مقدمتها المجاهدون المسلمون. وعاد الإسلام عزيزاً وصار قوة أولى ليس في ديار المسلمين فقط، بل في كل أرجاء المعمورة، مما فتح معارك شرسة في قلب العالم الغربي في محاولة للي الأذرع.. فكانت معركة المرتد رشدي ومعركة الحجاب وغيرها. ومرة أخرى استطاع الإمام عبر موقع صغير أن يفتح المعركة في المواقع الكبرى. فكان ما فعلته ردود الفعل على الفتوى نتائج أخطر من الفتوى ذاتها.. إذ أظهرت نوعاً من الوحدة الإسلامية تظهر للمرة الأولى في العالم الإسلامي، وكشفت أن الإسلام بات يمتلك كلمة يقولها وعلى الآخرين أن يدركوا ذلك. ومن ذات المنطلق وجه الإمام رسالته الشهيرة إلى غورباتشوف مشيراً بوضوح لا يقبل الشك إلى تفكك الإمبراطورية الروسية وتداعي النظرية الماركسية. فسخرت منه الصحافة الغربية، بل سخر منه بعض "المسلمين"، ولكن ما هي إلا شهور إلا وتداعت حكومات أوروبا الشرقية الشيوعية، وبدأت مظاهر تفكك الاتحاد السوفياتي تتوضح أكثر فأكثر، وظهرت للمرة الأولى منذ قرون قوى إسلامية جديدة في أذربيجان وطاجيكستان والصين وبلغاريا ويوغوسلافيا واليونان وغيرها من البلدان أضافت للمد الإسلامي مدا جديداً أخذ يعلب دوراً متزايداً في موازين القوى العالمية والعلاقات بين الدول.
من كان سيصدق قبل عشر سنوات أن العالم سيشهد كل هذه التطورات وأن ينتقل الإسلام من قوة مغيبة كلياً إلى قوة حاضرة وحية فاعلة على المسارح الوطنية والإقليمية والدولية.
لقد أطلق الإمام الشرارة، وكما هو شأن معارك الأنبياء عليهم السلام والسائرين على خطهم، فإن النجاح أو الفشل لا يقاس بالانتصار في حرب أو في الوصول إلى منصب، بل يقاس أولاً بالمنهاج الذي يغرسونه وبالخط المتصاعد الذي يطلقونه والشروط التي يوفرونها. فقد انتصر موسى (عليه السلام) على فرعون وفرعون ما زال ملكاً. وانتصر محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) رغم مؤامرات قريش. إذ كما يقول الإمام: "نضحي بأغلى وأعز ثمرات حياتنا ثم نحتفل بتلك التضحية".
فالإمام قد نجح أكثر من أي قائد آخر في دفع مسيرة الإسلام وتبوئها مركزها عالمياً لا سابق له. لقد عاد الإسلام اليوم كرسالة عالمية، كرؤية كونية، وإن التطورات الجارية اليوم في انهيار الكتلة الشرقية وما يتوقع من ثائر الكتلة الغربية هي الأخرى بهذا الانهيار يضع على المسلمين مهمة عظيمة وشريفة لإنقاذ الوضع الدولي من التوازن القائم على الرعب والخوف والهيمنة واستبداد القوى العظمى وإحلال التوازن القائم على الحق والعدل والتعاون بين الشعوب وارتفاع كلمة الله وعلوها على ما سواها.
| |
|
|
|
|
|





