|
|
عضو برونزي
|
|
رقم العضوية : 20772
|
|
الإنتساب : Aug 2008
|
|
المشاركات : 1,243
|
|
بمعدل : 0.19 يوميا
|
|
|
|
|
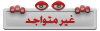

|
كاتب الموضوع :
ملاعلي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
 بتاريخ : 12-12-2008 الساعة : 03:13 AM
بتاريخ : 12-12-2008 الساعة : 03:13 AM
منطقة الجحفة (غدير خم )
للتوضيح حيث في موقع العلامة الكتابة صغيرة
مقدّمة:
اكتسبت الجحفة أهميتها كموضع جغرافي من العوامل التالية:
1. وقوعها مرحلة من مراحل طريق الهجرة النبوية الشريفة.
2. كونها مفترق طرق تؤدي إلى الحرمين الشريفين، وإلى ينبع حيث المرفأ البحري والطريق الشامي الساحلي.
3. والعامل الثالث هو العامل الديني حيث اعتبرت الجحفة شرعاً من المواقيت الخمسة، التي وقّتها رسول الله (ص) للحجاج والمعتمرين من المسلمين.
4. وقد يضاف إلى هذه عامل آخر، هو العامل التاريخي إذ مرت على الجحفة عهود تقدّم وازدهار، وعهود تأخر واندثار تسترعي انتباه الباحث وتستدعيه للبحث فيها.
وبغية أن نتبين هذه لابد من تصنيف البحث ـ وفي ضوئها ـ إلى النقاط التالية:
- اسمها.
- موقعها الجغرافي.
- تاريخها الماضي.
- حاضرها.
- دليل شرعيتها كميقات ومشروعية الإحرام منها.
- الطرق المارّة بها.
اسمها:
كانت تعرف قديماً باسم (مهيعة).
وضُبط الاسم لدى المشهور بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء المثناة تحت، وفتح العين المهملة، فتاء مربوطة.
وذكر السياغي في (الروض النضير) 3/ 142: أن القاضي عياضاً حكى عن بعضهم: كسر هائها، وعلّق عليه بأنه غير مشهور.
وهو مأخوذ من هاع هَيعاً ـ بفتح الهاء ـ وهيعاناً، بمعنى انبسط، أو من هاع هِياعاً ـ بكسر الهاء ـ بمعنى اتسع وانتشر.
قال الخليل في (العين مادة هيع ـ): وطريق مهيع من التهيع، وهو الانبساط، وبلد مهيع أيضاً أي واسع، قال أبو ذؤيب:
فاحتثهن من السواء وماؤه بئر وعانده طريق مهيع
وقد يرجع هذا إلى اتساع واديها وانتشاره وانبساطه حيث يبدأ بغدير خم عند نهاية وادي الخرار واسعاً، ويستمر متسعاً ومنبسطاً حتى يصب في البحر.
ثم سميت (الجحفة).
وضبط الاسم ـ من غير خلاف ـ بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وفتح الفاء، بعدها تاء مربوطة.
وذكر الاسم في (الصحاح) بغير أل، وفي كثير من الكتب سواه بالألف واللام من أولها.
وسميت بهذا الاسم لأن السيل اجتحفها( [1] ) في قصة أخوة عاد، التي ينسبها اللغويون إلى ابن الكلبي المؤرخ المتوفى سنة 204 هـ، إذ زعم «أن العماليق (وهم ولد عمليق بن لاوذ بن ارم) أخرجوا بني عَبيل ـ وهم أخوة عاد (بن عوض بن ارم) ـ من يثرب فنزلوا الجحفة ـ وكان اسمها مهيعة ـ فجاءَهم سيل فاجتحفهم فسميت جحفة»( [2] ).
وقد جاء فيما روي عن رسول الله (ص) أنه استخدم الاسمين معاً، حيث نقل عنه (ص) فيما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عنه (ص) أنه قال ـعند دخوله المدينة المنورة وكانت يومها موبوءة ـ: «اللهم انقل وباء المدينة إلى مهيعة».
وفيما رواه البخاري من طريق هشام أيضاً عن أبيه عن عائشة في حديث هجرة النبي (ص)، قالت: لما قدم رسول الله (ص) المدينة وَعِكَ أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبتِ كيف تجدك؟، ويا بلال كيف تجدك؟، قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:
كل امرئ مصبّح في أهلهه والموت أدنى من شراك نعله
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّى يرفع عقيرته ويقول:
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادٍ وحولي إذخر وجليــــــل
وهل أردن يوماً ميـاه مجنّــة وهل يبدون لي شامة وطفيل؟
قالت عائشة: فجئت رسول الله (ص) فأخبرته، فقال: (اللهم حبّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدّ، وصححها، وانقل حمّاها إلى الجحفة).
وكذلك اُستخدم الاسمان في حديث أهل البيت (ع)، ففي صحيح أبي أيوب الخزاز ـ الآتي فيما بعد ـ عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: ( ... ووقّت لأهل المغرب الجحفة، وهي عندنا مكتوبة مهيعة)( [3] ).
ولا يزال الاسمان يستعملان في بعض الكتب الشرعية، إلاّ أن اسم مهيعة انحسر من الاستعمال الاجتماعي، فلا يعرف المكان عند أبناء المجتمع سواء كانوا من أبناء المنطقة أو غيرها إلاّ باسم الجحفة.
موقعها الجغرافي:
اتبع الجغرافيون القدامى لتحديد الموقع الجغرافي لأي موضع يقع على طريق معروف المقياسين التاليين:
1. ذكر المدينتين الرئيستين اللتين يبدأ الطريق بإحداهما وينتهي بالأخرى، فيقولون ـ مثلاً ـ الموضع الفلاني يقع بين مكة والمدينة، أو بين البصرة والكوفة.
2. تقدير الموضع بالمرحلة بالنسبة إلى إحدى المدينتين، فيقولون ـ مثلاً ـ هو على مرحلتين من مكة، أو على ثلاث مراحل من الكوفة. وتابعهم على ذلك بعض الفقهاء كما سنرى في ذكر مصادر التحديد فيما يلي:
ففي صحاح الجوهري ولسان ابن منظور حددت بموضع بين مكة والمدينة( [4] ). وكما ترى، أن مثل هذا التحديد لا يعيّن الموقع بالضبط والدقة، وذلك لكثرة المواضع الجغرافية بين مكة والمدينة، ولذا حاول بعضهم أن يكون أقرب إلى ضبط الموقع، فقال: هي منزل أو مكان بين مكة والمدينة، قريب من رابغ، بين بدر وخليص، كما فعل هذا الفيومي في (المصباح المنير)، والطريحي في (مجمع البحرين)( [5] ).
ومتى علمنا جغرافيًا أن القرى المشهورة، التي تقع على هذا الطريق بين (بدر) و (خليص) هما (رابغ) و(مستورة)، وأضفنا إليه القرينة التي ذكراها، وهي أن الجحفة قريبة من رابغ، وليس من مستورة، يكون التحديد ـ هنا ـ أقرب إلى تعيين الموقع، إذ إننا وعلى مقياس آخر من المقاييس المستخدمة قديمًا، وهو سؤال سكان المنطقة عن الموقع، يكون التحديد قد أوقفنا على الموقع الجغرافيلها.
أما تحديد الموقع بالمرحلة، فقد قدّر بالتالي:
- ثلاث مراحل من مكة( [6] ).
- أربع مراحل من مكة( [7] ).
- خمس مراحل من مكة( [8] ).
- ست مراحل من المدينة( [9] ).
ويرجع هذا الاختلاف في عدد من المراحل بين ثلاث وأربع وخمس إلى الاختلاف في:
1. المراد من المرحلة.
2. الطريق.
فالقائلون بالثلاث أرادوا بالمرحلة المسافة بين المنزلين، وبالطريق طريقالهجرة.
والمنازل في هذا الطريق من مكة الى الجحفة، هي: مكة ـ عُسفان ـ خيمة أم معبد ـ الجحفة.
فالمسافة بين مكة وعسفان مرحلة، وبين عسفان والخيمة مرحلة، وبين الخيمة والجحفة مرحلة.
والقائل بالخمس أراد بالمرحلة المنزل، وبالطريق الطريق السلطاني، ومنازله ـ بعد مكة ـ هي:
1. الجموم 2. عسفان 3. الدف 4. الطارف 5. الجحفة.
وكذلك القائل بالأربع أراد بالمرحلة المنزل، وبالطريق الطريق السلطاني، إلاّ أنه حذف (الطارف) لعدم ذكره في بعض الخرائط.
أما المعاصرون من الفقهاء فاتبع بعضهم في تحديد الموقع الجغرافي للجحفة مقياس المسافة المقدرة بالكيلومتر.
منهم: السيد الكلبايكاني في رسالته العملية (مناسك الحجّ) قال: «والمسافة بين جحفة ومكة المكرمة مائتين وعشرين كيلومتراً تقريباً»( [10] ).
ومنهم: الشيخ سيد سابق في كتابه (فقه السنّة) 1/ 652 قال: «ووقّت لأهل الشام الجحفة: موضع في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها 187 كيلومتراً».
والمسافة ـ كما في خريطة وزارة المواصلات السعودية للطرق البرية في المملكة ـ من مكة إلى مطار رابغ 180 كيلو متراً، ومن مطار رابغ إلى الجحفة 9 كيلومترات، فالمجموع 189 كم.
والمواضع التي يمر بها الطريق حالياً هي:
- مكة.
- الجموم.
- عسفان.
- خليص.
- المفرق (مفرق الطريق إلى جدة والمدينة).
- صعبر.
- رابغ (مطار رابغ الواقع قبل مدينة رابغ من جهة مكة المكرمة وبعدها من جهة المدينة المنورة).
- الجحفة.
يسلك إليها الآتي من مكة يمنة الطريق، والآتي من المدينة يسرة الطريق ـ كما سأوضحه فيما بعد.
والذي حدّد المسافة بست مراحل من المدينة المنورة أراد بالمرحلة المنزل وبالطريق السلطاني أيضًا.
ومنازله بعد المدينة ـ هي:
1. الفريش 2. المسيجيد 3. السقيا 4. بئر مبيريك 5. الأبواء 6. الجحفة.
ونخلص من جميع ما تقدم ـ وفي هدي ما ذكر على صفحات الخرائط ـ إلى النتيجة التالية:
1. تقع الجحفة شرقي مدينة رابغ مع ميل إلى الجنوب.
2. يوصل إليها بسلوك أحد طريقين يدلفان إليها من طريق المدينة مكة جدة العام:
أ. أحدهما من مركز مدينة رابغ، وطوله 22 كم.
ب. وثانيهما من مطار رابغ وطوله 9 كم.
تاريخها الماضي:
إن قصة نزول بني عَبيل الجحفة بعد أن أخرجهم العماليق من يثرب ـ التي تقدمت الإشارة إليها ـ تشير إلى قدم الجحفة، وإلى أن تاريخها يرجع إلى ما قبل الإسلام.
قال الزبيدي في (تاريخ العروس: مادة جحف): «وكانت تسمى مهيعة، فنزل بها بنو عَبيل ـ كأمير باللام، وهو الصواب، وفي بعض بنو عُبيد كزبير بالدال، وهو غلط ـ وهم إخوة عاد بن عوص بن ارم، وكان أخرجهم العماليق، وهم من ولد عمليق بن لاوذ بن ارم من يثرب، فجاءهم سيل الجحاف، فسميت جحفة، قال ابن دريد: هكذا ذكره ابن الكلبي».
والعمالقة ـ كما يعرّفهم القلقشندي( [11] ): «قبيلة من العرب العاربة والبائدة، وهم بنو عمليق ـ ويقال عملاق ـ بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح (ع)، وهم أمّة عظيمة يضرب بهم المثل في الطول والجثمان، قال الطبري: وتفرقت منهم أمم في البلاد، فكان منهم أهل المشرق، وأهل عُمان والبحرين والحجاز، وكان منهم ملوك العراق والجزيرة وجبابرة الشام وفراعنة مصر».
أما بنو عَبيل فذكرهم القلقشندي( [12] ) عن ابن الكلبي بالدال، فقال: «بنو عبيد: قبيلة من العرب البائدة، قال ابن الكلبي: وهم بنو عبيد بن أرم بن سام بن نوح (ع) وقيل: عبيد بن صداد (شداد) بن عاد بن عوص بن سام، قال في العبر: وكانت منازلهم بالجحفة بين مكة والمدينة، وهو ميقات الإحرام لأهل مصر، فهلكوا بالسيل، ويقال: إن الجحفة بين مكة والمدينة، وإنما سميت الجحفة; لأن السيل أجحف بها وخربها.
قال المسعودي: ومنهم الذي اختط مدينة يثرب، وهو يثرب بن باسة بن مهلهل بن أرم بن عبيل، والذي ذكره السهيلي: أن الذي اختط مدينة يثرب هو ابن عبيل هذا».
ويبدو أن الجحفة بقيت عامرة بعد سيل الجحاف حتى القرن الخامس الهجري، فقد ذكر البكري البلداني المتوفى سنة 487 هـ الجحفة في كتابه (معجم ما استعجم 1/367) وعرّفها بقوله: «وهي قرية جامعة لها منبر». ووصفها بأن في أولها ـ أي من جهة المدينة ـ مسجد النبيّ (ص) بموضع يقال له (عزور)، وفي آخرها ـ أي من جهة مكة ـ عند العلمين مسجد الأئمة.
وربما كان خرابها في القرن السادس الهجري، ويفاد هذا مما جاء من تعريف لها في (معجم البلدان 2/111) فقد قال مؤلفه ياقوت الحموي المتوفى سنة 626 هـ: «الجحفة ـ بالضم ثم السكون فالفاء ـ كانت قرية كبيرة ذات منبر... وهي الآن خراب».
والذي يظهر أنها بقيت خراباً حتى عصرنا هذا.
وقد يرجع هذا إلى ما تُمنى به المدن والقرى الواقعة على الطرق العامة عند عدول السابلة إلى طريق آخر فتهجر لانقطاع مورد المعيشة فيها، وهو تعامل أهلها مع السالكة والسابلة المارة بها.
حيث يفاد مما يذكره الرحالة من مصريين ومغاربة( [13] ) أن طريق الحاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة المار بـ (بدر) فـ (الجحفة) عدل عنه، فانحدر من (بدر) إلى (مستورة) فـ(رابغ).
هذا كلّ ما وقفت عليه من تاريخها الماضي، وبخاصة في العهد الإسلامي.
ونستطيع أن نخلص منه إلى النتائج التالية:
1. أن الجحفة حتى القرن الخامس الهجري كانت قرية كبيرة جامعة ذات منبر.
2. وكان يطلق على أولها ـ للداخل إليها من جهة المدينة المنورة ـ اسم (عزور)، وكان فيه مسجد يقال له (مسجد النبيّ)، وهو المسجد الجامع الذي فيه منبرها لإقامة صلاة الجمعة.
3. وفي آخرها ـ للخارج منها إلى جهة مكة المكرمة ـ مسجد يقال له (مسجد الأئمة).
4. وفي نهايتها ـ من جهة مكة المكرمة أيضاً ـ عَلَمان أي علامتان من البناء الثابت لبيان حدود الميقات أو نهاية الميقات.
حاضرها:
قمت بثلاث زيارات ميدانية أو رحلات استطلاعية لموقع الجحفة في التواريخ التالية:
- الرحلة الأولى في أوائل سنة 1402 هـ .
- الرحلة الثانية في 7/5/1402 هـ = 2/3/1982م.
- الرحلة الثالثة في 18/6/1409 هـ = 25/1/1989م.
ففي الرحلة الأولى: ذهبت إليها من جدة بسيارة سوبربان شفرليت، وكان برفقتي ولدي إياد، وعندما وصلنا مطار رابغ نزلت يمنة الطريق إلى أرض رملية صخرية غير ممهدة، وليس فيها علامات واضحة يهتدي بها السائر إلى الجحفة، فتوقفنا خشية أن نضل الطريق ريثما نرى من نسير معه، فأقبلت علينا سيارة داتسون وانيت فاستوقفتها وسألتُ صاحبها عن الطريق، فقال: معي، لأن طريقي يمر بالميقات، وعندما بانت لنا منارة المسجد انطلق إلى جهته مسرعاً وتركنا نتخذ من المنارة مناراً نهتدي به. وحين وصلنا عند باب المسجد ترجلنا ودخلنا المسجد، فرأيناه قد لعبت به سوافي الرمال وغطّت فرشه، ورأينا فيه خزانات ماء للاستسقاء ومنها للغسل في حماماته الملحقة به.
وبالتفاتة إلى إحدى زوايا المسجد رأينا بدوياً متوسداً يده وغاطاً بنوم عميق، وقدرنا أنه خادم المسجد فأيقظناه وسألناه بعض الأسئلة عن الموقع، فقال: إن هذا المسجد شيد قريباً من قبل الحكومة السعودية وملاصقاً لأسس المسجد القديم، وأرانا شيئاً منها، وهي آثار مسجد الأئمة الذي تقدم ذكره، ثم أرانا بجواره بئراً قديمة مطمورة، ثم صعدنا على سطح المسجد ورأينا على بعد ستمائة متر شرقي هذا المسجد بئر ماء ليست بالقديمة يستقي منها الرعاة وأعراب المنطقة، ثم أشار إلى امتداد قرية الجحفة حتى قصر علياء، ولأن سيارتنا ليس فيها (الدبل) المساعد على السحب، لم نستطع الذهاب إليه لمعرفة مسافة القرية القديمة طولاً لوجود كثبان كثيرة من الرمال تجمعت بفعل السيول، فشكرناه، وعدنا أدراجنا إلى جدة.
وفي الرحلة الثانية: استعرت سيارة جيب تويوتا، وصحبت معي ولدي عمادًا، وكان برفقتنا خاله المرحوم السيد ياسين البطاط، وابنه السيد فاضل، وتجاوزنا المسجد المذكور إلى قصر علياء، ويبدو من أطلاله أنه أثر عباسي، وإلى جنبه آثار سوق قديمة وطريق صخري عفّى عليها الذاري. والمسافة بين المسجد الماثل وأطلال القصر أربعة كيلومترات أو تزيد قليلاً.
وفي الرحلة الثالثة: كان مركبنا سيارة جيب تويوتا أيضًا، مستعارة، والرفقة: الخطيب الشيخ صالح العبيدي والشاب عابد العلاّسي من جدة، وولداي معاد وفؤاد، وابنا عمتهما السبطان السيدان الحسن والحسين الخليفة، ورأينا الطريق من مطار رابغ حتى المحرم قد عبدته الحكومة السعودية وزفتته، وذلك بطلب من الحكومة الإيرانية.
كما أننا رأينا مسجداً جديداً كبيراً شيد على موقع المسجد السابق بعد تهديمه، وفيه مرافق من مراحيض وحمامات للرجال وللنساء، عملته الحكومة السعودية بعد تزفيت الطريق المذكور.
وأيضاً رأينا إلى جانب قصر علياء ـ كما يسميه أعراب المنطقة، ولم أعرف وجه التسمية ـ قريباً منه، مسجداً آخر، غير مسقوف، قيل إن الذي بناه رجل من شيعة حرب القاطنين بوادي الفرع.
«ويسكن أرض الجحفة اليوم قبائل من زبيد، منهم: الزنابقة والروايضة والعصلان، تخالطهم عناصر من عوف»( [14] ).
ونخلص مما تقدم إلى التالي:
1. المسجد المحرم يقع في أرض تلاصق آثار مسجد الأئمة، قبيل نهاية القرية القديمة من جهة مكة.
2. وفي نهاية القرية القديمة من جهة المدينة المنورة، أي في حي عزور تقوم أطلال قصر علياء.
3. إلى جانب قصر علياء مسجد صغير غير مسقوف أنشئ حديثاً.
4. والمسافة ما بين المسجدين لا تزال رمالا وصخوراً، لا تسلك إلاَّ بسيارة جيب وأمثالها.
5. الطريق من المسجد الَمحْرَم إلى طريق المدينة ـ مكة العام مزفت، وبطول تسعة كيلومترات.
6. ومن رؤيتنا لآثار القرية القديمة تحققنا من أن المسجدين الحديثين المذكورين، وما بينهما من الميقات، ذلك أن الميقات هو القرية الماثلة حال صدور النصوص الموقتة لها.
دليل شرعيتها:
ويتلخص الدليل على اعتبار قرية الجحفة ميقاتاً بالتالي:
1. السيرة العملية القطعية المتصلة بعصر التشريع، المسلمون يحرمون منها منذ عصر النبيِّ (ص) حتى عصرنا هذا.
2. اتفاق فتوى فقهاء المسلمين وتسالمهم على ذلك.
3. النصوص الشرعية المعتبرة، وهي كثيرة، منها:
ـ صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع)، قال : من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله (ص)، لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم، فإنه وقّت لأهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبلأهل العراق، ووقّت لأهل اليمن يلملم، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله( [15] ).
ـ صحيح أبو حسن الحلبي، قال : قال أبو عبد الله (ع): الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (ص) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة يصلى فيه، ويفرض الحج، ووقّت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل نجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (ص)( [16] ).
ـ صحيح أبي أيوب الخزار، قال : قلت لأبي عبد الله (ع): حدثني عن العقيق أَوَقْتٌ وقّته رسول الله (ص)، أو شيء صنعه الناس؟ فقال: إن رسول الله (ص) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفه ووقت لأهل المغرب الجحفة ـ وهي عندنا مكتوبة مهيعة ـ ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيقوما أنجدت( [17] ).
ـ صحيح علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الأوقات، التي وقتها رسول الله (ص) للناس، فقال: إن رسول الله (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة،وهي الشجرة، ووقّت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق( [18] ).
ـ و عن ابن عباس: أن رسول الله (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هي لهم، و لكل آتٍ أتى عليهن من غير هن ، ممن أراد الحجّ والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة( [19] ).
وقد أفاد فقهاؤنا الإماميون فتواهم من هذه، ونصّوا عليه:
ففي (فقه الرضا)( [20] ) و(المقنع)( [21] ): «وقّت لأهل الشام المهيعة و هي الجحفة».
وفي (الهداية)( [22] ) و(المقنعة)( [23] ): «وقت الأهل الشام الجحفة»، وكذلك في (النهاية)( [24] ) و(الجمل والعقود)( [25] ) و(السرائر)( [26] ) وفي (المواسم)( [27] ) و (الجامع)( [28] ): «وميقات أهل الشام الجحفة». وفي (الإصباح)( [29] ) و(الغنية)( [30] ): «ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختياراً، واضطراراً الجحفة، وفي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختياراً».
وهذا المذكور في (القواعد) من أن الجحفة ميقات اضطراري لمن لم يحرم من ذي الحليفه عند مروه عليه، واختياري لمن لم يمر على ميقات قبله، هو رأي مشهور فقهاء المسلمين، ما عدا المالكية من المذاهب السنيّة فقد ذهبوا إلى أن الجحفة ميقات تخييري لمن مرّ على المدينة من أهل الشام خاصة، فيتخير الشامي المار بالمدينة بين الإحرام من ذي الحليفة والإحرام من الجحفة.
قال ابن حزم في (المحلّى)( [31] ): «وفي بعض ما ذكرنا خلاف.. ومنه: أن المالكيين قالوا: من مرّ على المدينة من أهل الشام خاصة، فلهم أن يدعوا الإحرام إلى الجحفة; لأنه ميقاتهم، وليس ذلك لغيرهم».
ولعلهم بهذا يأخذون بظاهر الأمر الوارد في بعض نصوص التوقيت من غير اعتبار لقرينة أن طريق الشاميين عصر التشريع (صدور النصوص) كان على الجحفة.
ومن هذه النصوص ما رواه الإمام مالك في (الموطأ)( [32] ) عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله (ص) قال: يهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهلّ أهل الشام من الجحفة.. الخ»..
وعنه أيضاً أنه قال: «أمر رسول الله (ص) أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة.. الخ».
وإليه ذهب بعض فقهائنا الإماميين ـ مع فارق عدم قصره على أهل الشامـ استناداً إلى بعض النصوص الدالة بظاهرها على هذا، قال الشيخ المظفر في (كتاب الحجّ من شرح القواعد)( [33] ): «هذا كلّه في ميقات أهل المدينة اختياراً وأما اضطراراً فميقاتهم الجحفة ـ وهي المهيعة ـ بلا كلام في جواز الإحرام بها اضطراراً، بل قيل بجوازه اختياراً لقوله في صحيح علي بن جعفر(ع): «وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة» فإنه ظاهر في التساوي بين الوقتين فيتخير بينهما اختياراً، ودعوى إجماله لاحتمال إرادة الجمع بينهما باطلة، لمعلومية عدم لزوم الجمع بين وقتين فلا بد من أن يراد التساوي بينهما.
وصحيح معاوية بن عمار: «عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس».
ونوقش فيه باحتمال مرور الرجل على طريق الشام فأحرم من الجحفة، وتخيل السائل لزوم إحرامه من الشجرة وإن مرّ على غيرها لكونه من أهل المدينة فأجابه الإمام بعدم البأس.
ويشكل بأن الاحتمال لو سلم لا يضر في العموم المستفاد من ترك الاستفصال الشامل لصورة الإحرام من الجحفة مع خروجه من المدينة.
وصحيح الحلبي: «من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ قال: من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة الاَّ محرماً»، فإنه أجاز الإحرام من الجحفة من دون تقييد بالاضطرار وعسر العود إلى الشجرة، بل هو ظاهر في الاختيار لقوله «ولايجاوز الجحفة إلاَّ محرماً».
وصحيح أبي بصير: «قلت لأبي عبد الله (ع): خصال عابها عليك أهل مكة، قال: وما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله (ص) أحرم من الشجرة، فقال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً» فإنه ظاهر بأنهما بمرتبة واحدة في الإجزاء اختياراً، فلا يضر الأخذ بأقربهما إلى مكة خصوصاً مع العلة.
وخبر معاوية أو صحيحه: «قلت لأبي عبد الله (ع): إن معي والدتي، وهي وجعة، قال: قل لها فلتحرم من آخر الوقت، فإن رسول الله (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة، قال: فأحرمت من الجحفة».
فإن تعليله (ع) للأمر بإحرامها من آخر الوقت بتوقيت رسول الله (ص) للمواقيت ظاهر في كفاية الإحرام من أي وقت كان بلا دخل للوجع فيه.
ولعلّ الأصحاب إلاّ النادر خصّوا إحرام أهل المدينة من الجحفة بحال الاضطرار لظهور المستفيضة في اختصاص كلّ مصر بميقات فتخص الأخبار السابقة بحال الاضطرار، كما يشهد له خبر الحضرمي الدال على أن الصادق (ع) اعتذر عن إحرامه من الجحفة، وهو شاكٍ، بقوله: «قد رخص رسول الله (ص) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» فإنه ظاهر في أنه رخصة للضرورة لا مطلقاً».
كما كان الأمر كذلك عند فقهاء أخواننا أهل السنّة حيث أفتوا بذلك استناداً إلى ما تقدم من أدلة وأمثالها.
ففي (متن الخرقي)( [34] ): «وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة».
وفي (الروض المربع)( [35] ): «وميقات أهل الشام ومصر والمغربالجحفة».
وفي «الفقة على المذاهب الأربعة»( [36] ): «فأهل مصر والشام والمغرب، ومن وراءهم من أهل الأندلس والروم والتكرور، ميقاتهم الجحفة».
وفي (فقه السنّة)( [37] ): «ووّقت لأهل الشام الجحفة... وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام، ومن يمرّ عليها بعد ذهاب معالم جحفة».
وفي (التحقيق والإيضاح)( [38] ): «الثاني: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ( [39] )، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ( [40] ) قبلها بيسير».
ويلاحظ على قول صاحب فقه السنّة (وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام.. الخ): أن اندراس معالم الميقات لا يخرجه عن كونه ميقاتاً، والإحرام مما قبله من الأمكنة إحرام مما قبله من الأمكنة إحرام قبل الميقات يخضع لأحكام الإحرام قبل الميقات من حرمة بغير نذر، أو جواز على كراهة أو بلا كراهة.
والصواب أن يعبّر عنه بـ(الَمحْرمَ) بدلا من الميقات.
قال ابن قدامة في (المغني)( [41] ): «وإذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر، فموضع الإحرام من الأولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية; لأن الحكم تعلق بذلك الموضع، فلا يزول بخرابه، وقد رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع الوادي فأتي به المقابر، فقال: هذه ذات عرق».
وكذلك يلاحظ على قول صاحب التحقيق والإيضاح: «ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات»، أن الإحرام قبل الميقات لا يجعل المكان الذي يحرم منه ميقاتاً، قريباً كان ذلك المحرم من الميقات أو بعيداً عنه.
ويرجع هذا إلى أن التوقيت حكم توقيفي ثبت بالنصّ الشرعي، فتجاوزه لا يعدو أن يكون اجتهاداً في مقابل النصّ، وهو محظور عند جميع المسلمين.
وفي المناسك الحديثة لفقهائنا المعاصرين نقرأ أمثال العبارات التالية:
«الثالث: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر ومَن عبر على طريقهم إلى مكة من أهل الآفاق الأُخَر، إذا لم يمر بميقات آخر، أو مرّ به وتجاوزه ولم يمكنه الرجوع إليه والإحرام منه»( [42] ).
«3. الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وكلّ من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها»( [43] ).
«ثالثاً: الجحفة: وهو لأهل الشام ومصر، ومن يمر على طريقهم إلى مكة من أهل الآفاق والأقطار والأمصار الأخرى إذا لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بميقات وتجاوزوه بدون إحرام ولم يمكنهم الرجوع إليه والإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من جحفة»( [44] ).
ويلاحظ على هذه التعبيرات وأمثالها أنها استخدمت مضامين النصوص الشرعية بقولها: (وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب)، وأضافت عليها ما يعطي المشمولية للحكم بقولها: (وكل من يمر عليها).
واستخدام مضامين النصوص الشرعية كان قديماً من منهج التأليف الفقهي، وبخاصة في كتب الفتوى. وله ـ فيما أرى ـ ما يبرره لأن الطرق في عهود التأليفات الفقهية المبكرة بعد لما تزل على ما هي عليه في عصر صدور النصوص. أما الآن وقد تغيرت الطرق واختلفت فلا بد من مراعاة ذلك أثناء صياغة الفتوى; لأنها تعطى لعمل العامي، فأهل الشام ومصر والمغرب وغيرهم قد يسلكون طريق الجو فينزلون في مطار المدينة أو مطار جدة، وقد يسلكون طريق البحر فينزلون في ميناء جدة، وقد يسلكون طريق البر فيقصدون المدينة المنورة أو يقصدون مكة المكرمة عن طريق ساحل البحر الأحمر مروراً بينبع، والمواقيت لهم تختلف باختلاف هذه الطرق المذكورة، وكذلك باختلاف الرأي الفقهي في الإحرام من غير المواقيت الخمسة، فعليه لابد من التعبير بما يناسب الواقع الخارجي الماثل وقت تأليف المناسك ونشرها.
الطرق إلى الجحفة:
تعتبر الجحفة ميقاتاً اختيارياً لـ:
1. من يؤم مكة المكرمة عن طريق جدة جواً أو بحراً على رأي من لايجوّز الإحرام من جدة نذراً.
2. من يؤم مكة عن طريق ينبع بحراً.
3. من يؤم مكة من أبناء شمالي الجزيرة القاطنين في مدن وقرى وبوادي ساحل البحر الأحمر، ومن يمر على طريقهم الساحلي البري من أبناء الأردن، ومن ينفذ إلى الطريق الساحلي المذكور عن طريق الأردن كأبناء العراق وسورية ولبنان وفلسطين وتركيا وإيران وغيرهم.
4. القاطنين في ديار وبوادي الحجاز قبل الجحفة وبعد ذي الحليفة، كأهل المسيجيد وبدر ومستورة والأبواء ورابغ ووادي الفرع، ومن إليهم.
وإليك المسالك البرية المؤدية أو المارة بالجحفة:
الطريق القديم إلى الجحفة (من المدينة إلى مكة):
المدينة ـ ذوالحليفة ـ الحفين ـ ملل ـ السيالة ـ الروحاء ـ خيف نوح ـ الخيام - الأثيل ـ بدر ـ الجحفة.
المدينة - ذوالحليفة - الحفين- ملل- السيالة - الروحاء-الرويثة - الصفراء - بدرـ الجحفة.
المدينة - ذوالحليفة - الحفين- ملل- السيالة - الروحاء - الرويثة - الاثاية - العرج - السقيا - الأبواء - الجحفة.
المدينة - ذوالحليفة - الحفين- ملل - السيالة - الروحاء - الرويثة - الاثاية - العرج - السقيا - الأبواء - ودان - عقبة هرش - ذات الاصافر - الجحفة.
الجحفة - الطارف - الدف- عسفان - الجموم (مر الظهران) - مكة.
الجحفة - خيمة أم معبد - عسفان - الجموم (مر الظهران) - مكة.
الطريق الحديث إلى الجحفة:
1. من المدينة إلى مكة (طريق بري):
المدينة المنورة ـ المسيجيد ـ بدر ـ مستورة ـ رابغ (الجحفة) ـ القضيمة (المفرق)
خليص ـ عسفان ـ الجموم ـ مكة المكرمة.
القضيمة (المفرق)
ثول ـ ذهبان ـ جدة.
2. من وادي الفرع (أبو ضباع) (طريق بري):
أبو ضباع ـ عقبة هرش ـ رابغ ـ (الجحفة).
3. من بدر (طريق بري):
بدر ـ مستورة ـ رابغ (الجحفة).
4. من الاردن الى الحرمين (طريق بري):
أ. العقبة ـ حقل ـ الشرف - بئر هرماس ـ تبوك ـ القليبة ـ تيماء ـ خيبر ــ المدينه المنوره.
العقبة ـ حقل ـ الشرف - البدع ـ ضُبا ـ الوجه ـ أُملج ـ ينبع المفرق - بدر ـ المسيجيد ـ المدينة المنورة.
العقبة ـ حقل ـ الشرف - البدع ـ ضُبا ـ الوجه ـ أُملج ـ ينبع المفرق - مستوره ـ رابغ (الجحفه) ـ القضيمة (المفرق) ـ خليص ـ عسفان ـ الجموم ـ مكة المكرمة .
العقبه ـ حقل ـ الشرف - البدع ـ ضُبا ـ الوجه ـ أُملج ـ ينبع المفرق - مستوره ـ رابغ (الجحفه) ـ القضيمة (المفرق) ـ ثول ـ ذهبان ـ جدة.
ب. معّان ـ حالة عَمار ـ بئر هرماس - تبوك ـ الفلبية ـ تيماء ـ خيبر ـ لمدينة المنورة.
معّان ـ حالة عَمار ـ بئر هرماس - الشرف ـ البدع ـ ضبا ـ الوجه ـ أملج ـ ينبع ـ المفرق - بدر ـ المسيجيد ـ المدينة المنورة.
معّان ـ حالة عَمار ـ بئر هرماس-الشرف ـ البدع ـ ضبا ـ الوجه ـ أملج ـ ينبع ـ المفرق - مستورة ـ رابغ (الجفة) ـ القضيمة (المفرق)ـخليص ـ عسفان ـ الجموم ـ مكة المكرمة.
معّان ـ حالة عَمار ـ بئر هرماس-الشرف ـ البدع ـ ضبا ـ الوجه ـ أملج ـ ينبع ـ المفرق -مستورة ـ رابغ (الجفة) ـ القضيمة (المفرق)ـنول ـ ذهبان ـ جدة.
المراجع
1. تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي، (القاهرة: م الخيرية 1306 هـ) ط1 «مصورة».
2. التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنّة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرياض: م الأمن العام 1397 هـ) ط 17.
3. خريطة الطرق لعام 1406 هـ، وزارة المواصلات ـ المملكة العربية السعودية (الرياض، مالأهلية للأفست 1406 هـ ـ 1986 م).
4. الروضالمربعبشرحزادالمستقنع،منصوربنيونسالبهوتي(القا هرة:مالسلفية 1392هـ) ط7.
5. الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي (الطائف: مكتبة المؤيد 1388 هـ ـ 1968 م) ط2.
6. الصحاح، إسماعيل بن حمّاد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار (بيروت: دار العلم للملايين 1404 هـ ـ 1984 م) ط 3.
7. صفة جزيرة العرب، الحسن بن أحمد الهمداني، تحقيق محمد بن علي الأكوع، (الرياض: دار اليمامة 1397 هـ ـ 1977 م).
8. على طريق الهجرة، عاتق بن غيث البلادي (مكة: دار مكة ـ) ط 1.
9. العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي (بيروت: مؤسسة الأعلمي 1408 هـ ـ 1988 م) ط1.
10. فقه السنّة، السيد سابق (بيروت: دار الكتاب العربي ـ).
11. الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري (بيروت: دار الكتب العلمية 1406 هـ ـ 1986 م).
12. كتاب الحجّ من شرح القواعد، الشيخ محمد حسن المظفر (النجف: م النعمان 1378هــ 1959 م).
13. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور (بيروت: دار صادر ـ).
14. مجمع البحرين، فخرالدين الطريحي، تحقيق أحمدالحسيني (بيروت: مؤسسة الوفاء 1403هـ ـ 1983 م) ط 2.
15. المحلّى، ابن حزم الأندلسي، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة (بيروت: دار الآفاق الجديدة ـ).
16. معجم البلدان، ياقوت الحموي (بيروت: دار صادر ودار بيروت 1404 هـ ـ 1974 م).
17. معجم معالم الحجاز، عاتق بن غيث البلادي (مكة المكرمة: دار مكة 1399هـ ـ 1979 م) ط1.
18. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد البكري، تحقيق مصطفى السقا (بيروت: عالم الكتب 1403 هـ ـ 1983 م) ط 3.
19. المغني، ابن قدامة (بيروت: دار الفكر 1405 هـ ـ 1985 م) ط 1.
20. مناسك الحج، السيد الخوئي (بيروت: دار الزهراء 1399 هـ) ط 9.
21. مناسك الحج، السيد الكلبايكاني (ـ 1396 هـ).
22. منهاج الناسكين، السيد الحكيم (النجف الأشرف: م النجف 1382 هـ) ط 6.
23. الموطأ (مع تنوير الحوالك)، الإمام مالك (بيروت: دار الفكر ـ).
24. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، أحمد بن علي القلقشندي، تحقيق علي الخاقاني (بغداد: م النجاح 1378 هـ ـ 1958 م).
25. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، الحر العاملي، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني (بيروت: دار إحياء التراث العربي 1403 هـ 1983 م) ط 5.
26. الينابيع الفقهية: الحجّ، تحقيق الشيخ علي أصغر مرواريد (طهران: مركز بحوث الحج والعمرة 1406 هـ) ط 1.
27. زيارات ميدانية، الفضلي.
([1]) قال ابن سيده: سيل جُحاف ـ بالضم ـ يذهب بكلّ شيء ويجحفه أي يقشره. اُنظر: اللسان ـ مادة جحف.
([2]) انظر: اللسان والتاج ـ مادة: جحف.
([3]) معجم ما استعجم 1/367 ـ 370.
([4]) اُنظر: مادة جحف فيها.
([5]) اُنظر: مادة جحف فيها.
([6]) الروض النضير 3: 142 والروض المربع 1: 135 ولسان العرب مادة جحف: حكاه عن البكري.
([7]) معجم البلدان 2: 111.
([8]) معجم معالم الحجاز 2: 122.
([9]) معجم البلدان 2: 111.
([10]) صوابه نحوياً: (مائتان وعشرون). ومن غيرشك أنه جاء من خطإ المترجم عن الأصل الفارسي أو من الناشر
([11]) نهاية الأرب 142.
([12]) م . س 321.
([13]) اُنظر: على طريق الهجرة، للبلادي ص 60.
([14]) على طريق الهجرة 57.
([15]) الوسائل: الباب 1 من المواقيت.
([16]) الوسائل: الباب 1 و 11 من المواقيت.
([17]) الوسائل: الباب 1 من المواقيت.
([18]) الوسائل: الباب 1 من المواقيت.
([19]) المحلى 7/71 عن صحيح مسلم 1/328.
([20]) الينابيع الفقهية 4.
([21]) م.س 20.
([22]) م.س 48.
([23]) م.س 69.
([24]) م.س 174.
([25]) م.س 227.
([26]) م.س 467.
([27]) م.س 239.
([28]) م.س 697.
([29]) م.س 256.
([30]) م.س 417.
([31]) 7/ 72.
([32]) 1/ 306 ـ 307.
([33]) 117 ـ 118.
([34]) المغني 3: 110.
([35]) 1/ 135.
([36]) 1/ 639.
([37]) 1/ 652.
([38]) 18.
([39]) الصواب: رابغًا.
([40]) الصواب: رابغًا.
([41]) 3/ 111.
([42]) منهاج الناسكين للسيد الحكيم، ط6 ص 30.
([43]) مناسك الحج للسيد الخوئي ط9 ص 66.
([44]) ص 41 من مناسك الحج للسيد الكلبايكاني.
| |
|
|
|
|
|